الجهاد
والحرب
بين
الفقه الإسلامي والقانون الدولي
الدكتور
جبر الهلّول
لم تنعم البشرية إلا بفترات سلم قليلة تكاد لا تذكر
أمام حالة الحرب التي تسيطر على سلوكها منذ فجر التاريخ البشري وحتى الآن. فهي
ملازمة لوجود الإنسان في هذه الحياة ولن تتخلف أبداً إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها. وهذا المقال لا يأتي في سياق دراسة الحرب كظاهرة بشرية اجتماعية، وإنما
يأتي في سياق المقارنة بين الجهاد والحرب
بين الفقه الإسلامي الذي تأصلت مصادره منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وبين الحرب في
القانون الدولي الذي وجد حديثاً مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
حيث كانت مصادره الأساسية عبارة عن اتفاقيات ومعاهدات دولية عقدت في
"لاهاي" و"جنيف"، وقد سميت تلك المعاهدات والاتفاقيات بـ
"قانون لاهاي" و "قانون جنيف". أما "قانون لاهاي"
فهو: «جملة القواعد التي تحويها معاهدات لاهاي المتعاقبة الخاصة "بقانون
الحرب"، والتي تم عقدها في أعوام (1899- 1907- 1922-1954) بالإضافة لتصريح
(سان بطرسبرج) عام (1868)، ومشروع "اتفاقية بروكسل" عام (1874)، وهذا
القسم من القواعد يتعلق "بقانون الحرب" بحد ذاتها، مثل قواعد القصف،
ومهاجمة المدن والتفاوض ووقف إطلاق النار والهدنة والاحتلال الحربي ...إلخ. أما
"قانون جنيف": هو جملة القواعد التي تحويها اتفاقيات ومعاهدات جنيف
الخاصة "بقانون الحرب" والتي تم عقدها في أعوام
(1864-1906-1929-1949-1977) ويسمى هذا القسم من " قانون الحرب باسم "القانون
الإنساني" لأن غايته جعل الحرب أكثر إنسانية بالتخفيف من أهوالها ما أمكن مثل
الاعتناء بالجرحى والمرضى، وحسن معاملة الأسرى، وحماية السكان المدنيين ومعاملة
الشيوخ والنساء والأطفال معاملة خاصة...إلخ»(1).
كما إن هذا المقال يأتي في سياق فهم مشروعية الحرب في القانون الدولي التي
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلادنا الإسلامية، والتي تشكل صدمة لنا
بمقارنتها لمفهومنا الإسلامي الذي شرع لنا الجهاد في سبيل الله تعالى ونظمه لنا.
أولاً: تعريف الحرب في الفقه الإسلامي:
إن البحث عن معنى الحرب في الفقه الإسلامي فيه صعوبة
بالغة، حيث لم يرد في كتب علماء المسلمين الأوائل لفظة الحرب، وذلك ربما لما في
هذه اللفظة من معنى الصراع والتناحر والاستيلاء على ما يملكه الغير، وإنما عبروا
عن هذا بلفظ الجهاد (2). وذلك لما في معنى
الجهاد من شمولية وأهداف سامية عادلة، وبخاصة أن معنى الجهاد يتضمن معنى الحرب
وليس العكس. ومن هنا لا يمكن معرفة معنى الحرب الذي تناوله العلماء المعاصرون في
مؤلفاتهم إلا من خلال معنى الجهاد في
الفقه الإسلامي.
تعريف الجهاد في سبيل
الله:
تناول علماء المسلمين
بحث معنى الجهاد وأحكامه وفضائله في مؤلفاتهم في أبواب المغازي والسير.
أ- الجهاد لغة: جاهد العدو
ومجاهدة وجهاداً، قاتله وجاهد في سبيل الله، وفي الحديث الشريف: "لا هجرة بعد
الفتح ولكن جهاد ونية". والجهاد محاربة الأعداء، والمبالغة واستفراغ ما في
الوسع والطاقة من قول أو فعل، والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم يبق بعد
فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار الإسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال
الكفار. والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء (3).
ب- الجهاد شرعاً: عرفه الشوكاني بقوله: «بذل الجهد
في قتال الكفار، ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة
النفس فعلى دفع ما يأتي به عن الشبهات وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار
فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما الفساق فالبيد ثم اللسان ثم القلب» (4).
فمن خلال تعريف الجهاد
لغة وشرعاً نجد أنهما يتفقان في بذل الجهد واستفراغ الوسع في قتال الكفار ويكون
ذلك باليد أو اللسان أو القلب وإلى هذا المعنى ذهب معظم الفقهاء. ويتضح ذلك من
استعراض بعض التعريفات للجهاد:
فقد عرفه ابن عرفة من
المالكية بقوله: «هو قتال المسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو
حضوره له، أو دخوله أرض له».
وقال الباجوري: «الجهاد
أي القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة وهي مقاتلة لإقامة الدين وهذا هو الجهاد
الأصغر وأما الجهاد الأكبر فهو مجاهدة النفس».
فمن خلال ما سبق نجد أن
الجهاد يلتقي مع الحرب في أن كليهما قتال، ولكن هذا القتال في الجهاد يأتي بعد
مرحلة مهمة وهي محاولة حقن الدماء بالطرق السلمية ولا يتم اللجوء إلى الحرب «إلا
عند اقتضاء الأمر للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد لتحقيق السعادة الشاملة
للبشرية في دنياها وأخراها كما ارتضاها الإله الحكيم، وكل جهد يبذل في هذا المضمار
فهو في سبيل الله وحده ولإرضائه فقط من دون أن يشوب نوايا المسلمين نزعة مادية أو
هوى شخصي أو تسلط على رقاب العالم وسيادة الأمم» (5).
فالجهاد لا يكون إلا
لإقامة المجتمع المسلم الذي تعلو فيه كلمة الله أكبر، الله أكبر من كل ظلم
واعتداء، الله أكبر تبسط على أجزاء الدولة الإسلامية للمحافظة على كيانها ووجودها
من أي خطر يهددها أو يهدد الدعوة الإسلامية، ويحاول أن يقف حجر عثرة في سبيل
استمرارها عندئذ لابد للحق أن يعلو ولابد للباطل أن ينزاح عن طريق الدعوة أولاً
وبعد استنفاد الطرق السلمية لابد من مقاتلة الممانعين والواقفين في وجه الدعوة
أملاً بجلب المصالح ودفع المضار.
ونخلص إلى أن الحرب في
الإسلام ما هي إلا جزء من الجهاد الإسلامي وتعني مقاتلة كل من يهدد الأمة
الإسلامية في دينيها وأمنها ويقف في طريق الدعوة ويعوق حرية انتشارها وازدهارها
على كل المستويات التي تحتاجها الأمة بعد استنفاد كل الطرق السلمية في تحقيق ذلك.
ثانياً:
تعريف الحرب في القانون الدولي:
إن تعريف الحرب لغة هي نقيض السلم(6)، وفي الاصطلاح الدولي لها تعريفات كثيرة
متقاربة في جانب ومتباعدة في جانب آخر. وأعرض لبعض هذه التعريفات للحرب بغية
الوصول إلى تعريف أدق وأوضح في إعطائنا المعنى الأقرب لواقع الحرب اليوم.
فنجد
مثلاً "محمد اللافي" في كتابه " نظرات في أحكام الحرب والسلم"
يعرف الحرب بقوله: «صراع مسلح بين دولتين أو أكثر لتحقيق مصالح وطنية»(7). ولكن هذا التعريف يثير تساؤلاً كبيراً
فما هي المصالح الوطنية التي تبرر نشوب الحرب؟!. لذلك نجد الكاتب نفسه يتحول إلى
تعريف آخر فيقول: «الحرب تعني الصراعات المسلحة وذلك عن طريق استعمال القوة
المسلحة بين دولتين أو أكثر بهدف الدفاع عن حقوق ومصالح الأطراف المتحاربة»(8). وهذا التعريف وإن كان أكثر وضوحاً من
الأول إلا أنه يشير إلى عدم استقرار الكاتب على تعريف محدد الحرب.
ويعرف
"محمود حسن أحمد" الحرب في القانون الدولي بقوله: «تعني الصراع المسلح
بين دولتين أو أكثر ذات سيادة. وهي استخدام القوة من أجل تحقيق النصر والتمكن من
الحصول على مصالح مادية وأخرى معنوية. وكل طرف يعتبر الطرف الآخر عدواً. ووفقاً
لهذا المفهوم فإن الاقتتال الذي يجري في الدولة الواحدة يعد اضطراباً داخلياً
وتمرداً وثورة»(9). ومن خلال هذا التعريف
نجد أن الحرب وفق المفهوم الدولي لا تكون إلا بين دول ذات سيادة، وبهذا يتضح الفرق
بين الحرب الداخلية والحرب الخارجية، إذ تقتصر الحرب على الحرب الخارجية، أما ما
يجري داخل الدول فهو اضطراب داخلي وتمرد وثورة. وإلى هذا المعنى ذهب "علي علي
منصور" في تعريفه للحرب عندما قال: «هي نضال بين قوتين مسلحتين لدولتين
متنازعتين، والأصل أن الحرب بين الدول»(10).
ولكن
يبدو لي أن تعريف "حامد سلطان" ـ في حدود ما سبق ـ للحرب أوضح وأدق عندما
يعرفها بقوله: « الحرب على وجه العموم ـ صراع بين دولتين أو أكثر يستخدم فيه
المتصارعون قواتهم المسلحة بقصد التغلب على بعضهم البعض وفرض شروط الصلح على
المغلوب كما يشاؤها الغالب. وهي في القانون الدولي حالة عداء مسلح بين دولتين أو
أكثر»(11).
وبعد
هذه التعريفات نلاحظ الاختلاف فيما بينها فمنهم من اعتبر الحرب صراعاً ومنهم
اعتبرها قتالاً ومنهم من اعتبرها صورة من صور التنافس البشري، وهكذا يبدو من خلال
ذلك اختلاف في تحديد حقيقة مصطلح مفهوم الحرب، وعلى هذا الأساس كان الاختلاف في
تحديد أهدافها التي كانت بحسب التعريفات إما لمصالح وطنية أو للدفاع عن حقوق
ومصالح الأطراف المتحاربة أو لفرض النصر لتحقيق مصالح مادية ومعنوية أو لتحقيق
مصالح سياسية بقوة السلاح، أو الصراع من أجل البقاء للأصلح والأقوى، أو لفرض
الغالب شروطه على المغلوب.
وهذا
الاختلاف في تحديد مصطلح الحرب يؤكد صعوبة تعريف دقيق لها، وهذا ما ذهب إليه
"وهبة الزحيلي بقوله: «الحرب اليوم يمكن أن تعرف بأنها حسم لخلاف دولي وحله
عن طريق القسر بعد تعثر الوسائل السلمية.
والنزاع
الدولي يرتبط بالكيان الاقتصادي والاجتماعي للدول فهو نتيجة محتمة لذلك مما يدفع
كل دولة أن تحافظ على مصالحها القومية، وتعد نفسها الحكم الأعلى لكل نزاع تكون
طرفاً فيه، وهذا تطور جديد في فهم الحرب، وبهذا ننتهي إلى أنه من الصعب وضع تعريف
محدد للحرب لا يمكن أن تقرر طبقاً لقاعدة مجردة»(12).
ثالثاً:
نقاط الالتقاء والافتراق بين تعريف الجهاد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي:
إنه
من خلال مقارنة تعريف مصطلح الجهاد عند الفقهاء المسلمين، وتعريف مصطلح الحرب عند
فقهاء القانون الدولي، نلاحظ أن هناك نقاط التقاء ونقاط افتراق بينهما. فالتعريفان
يلتقيان في اعتبار كل منهما مصلحة من مصالح الدولة العامة، ولها أحكام خاصة، وأنها
موجهة نحو عدو خارجي، والصراع أو القتال غالباً ما يكون بين طرفين أو أكثر.
أما
نقاط الافتراق بين المصطلحين فهي واسعة في الغاية والهدف والوسيلة، وبخاصة أن
الحرب في القانون الدولي حرب غير أخلاقية وغير إنسانية، ولا يحد من قوتها
التدميرية والتخريبية قيد أو شرط، ولا يحكمها قانون ضابط(13). بخلاف الحرب التي إذا قامت باسم
الإسلام كان لها هدف، ولا تكون حرباً حمقاء، ولا قتالاً لفتنة أو حمية عصبية أو
عنصرية، ولا تكون لهدف توسعي استعماري كهذه الحروب التي تخاض ضد المسلمين اليوم أو
تقع بين الدول غير الإسلامية(14).
كما إن الحرب قد تقوم لأسباب سياسية وأسباب
اقتصادية وأسباب وطنية وأخرى مادية أو معنوية كتحقيق النصر والغلبة وتسخير الشعوب
المغلوبة لمصلحتها. وهذا يعني أن الحرب يمكن أن تكون محقة، ويمكن أن تكون باطلة،
كما يمكن أن تكون عادلة، ويمكن أن تكون ظالمة، ويمكن أن تكون مشروعة ويمكن أن تكون
غير مشروعة. أما الجهاد فهو دائماً محق وعادل ومشروع(15). فلم يكن إلا وسيلة يستعان بها عند
الضرورة لحماية الأمة الإسلامية، وأمنها وسلامة أقاليمها بالإضافة إلى استعماله
لإقرار العدالة وشريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولهذا لم يكن الجهاد تدبيراً
عدوانياً، وإنما كان حرباً دفاعية وقائية مشروعة عن الإسلام والمسلمين.(16)وقد قال "وهبة الزحيلي": «إن
الحرب في ذاتها قبيحة لما فيها من قتل النفوس والتخريب والتدمير، لكن الجهاد في
سبيل الله تعالى حسن لغيره وهو إعلاء كلمة الله تعالى وحماية الدين الحق ومنع
الفتنة».(17)
رابعاً
: أهداف الحرب في القانون الدولي:
إن
الحرب في المجتمعات الدولية هي الوسيلة الغالبة لفض التنازع فيما بينه، لذلك حرص
القانون الدولي بداية على رفضها كمبدأ لحل النزاعات الدولية ووضع لها قواعد
تنظمها، لكنه لم ينجح لا نظرياً ولا عملياً في منع الالتجاء إلى القوة المسلحة أو
الحد من استخدامها(18). لذلك كانت الحرب في
القانون الدولي هي قانونية في الواقع، ومعترف بإمكانية قيامها(19)، ومشروعة في حالة الدفاع عن النفس الذي
يعتبر حقاً طبيعياً وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وذلك لأن الاعتداء
المسلح من أخطر ضروب انتهاك القواعد القانونية الدولية، فقد يؤدي إلى أفظع النكبات
التي تلحق بالجنس البشري وعلاوة على ذلك، فإن انتهاك السلام والتهديد بانتهاكه لا
يمس مصالح الدول بأجمعها فحسب، بل أيضاً بحقوقها(20).
فالأصل
إذاً في القانون الدولي هو السلم وأن الحرب لا يلجأ إليها إلا استثناء بعد استنفاد
الطرق السلمية في رد العدوان، عندئذ تكون الحرب مشروعة. لكن على صعيد الواقع
الدولي المعاصر توسعت الدول في تفسير معنى العدوان، وتذرعت بأوهى الأسباب للتدخل
في شؤون دولة أخرى، من أجل حماية مصالحها الاقتصادية، وفتح الأسواق العالمية أمام
تجارتها، ودفاعاً عن مصالحها وأغراضها. فالحرب في القانون الدولي لها مبرراتها
وأهدافها التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وإذا
كانت أهداف الحرب في الفقه الإسلامي هي أهداف سامية تتطلبها حماية الدعوة
الإسلامية، ولا تخرج عن كونها استعمالاً لحق من حقوق الدولة الطبيعية المعترف بها
في القانون الدولي المعاصر، وهي حق البقاء، وحق الدفاع الشرعي، وحق المساواة، وحق
الحرية، وحق الاحترام المتبادل. وكل هذه الحقوق تسوغ الباعث على القتال في الإسلام
والذي حدد بوجود حالة عدوان، سواء كان اعتداء مباشر أو غير مباشر على المسلمين أو
أموالهم أو بلادهم. فإننا نجد أن القانون الدولي قد ميز بين الحرب المشروعة والحرب
غي المشروعة تبعاً لأهداف كل منهما فأجاز الأولى ومنع الثانية، وهذه الأهداف تكون
في إحدى الحالتين: «أولاهما: أن تكون دفعاً لاعتداء وقع بالفعل....والثانية: أن
تكون الحرب لحماية حق ثابت للدول انتهكته دولة أخرى دون مبرر، وهذا من قبيل الجزاء
الذي تحمي به الحقوق. وأما الحرب غير المشروعة فتلك التي يقصد بها الفتح والرغبة
في السيطرة وبسط السلطان، ففرق الفقهاء في القانون الدولي الحديث بذلك بين الحرب
العادلة فأباحوا الأولى وحرموا الثانية»(21).
هذه الأهداف التي أبيحت لأجلها الحرب في القانون
الدولي ليست واضحة المعالم، وليست محددة في واقع الحرب الدولية لأنه ينطوي تحت كل
من هذين الهدفين أهداف كثيرة تبرر الحرب وتجعلها مشروعة مع كل ما تحمله الحرب
الحديثة من معاني الظلم والقوة والوحشية من أجل تحقيق مصالح ومكاسب مادية على حساب
الآخرين وسفك دمائهم. ولو عدنا إلى الهدفين اللذين تباح الحرب لأجليهما نجد أن «حق
الدفاع الشرعي حق يقرره القانون الدولة للدولة أو لمجموعة الدول باستخدام القوة
لصد عدوان مسلح حال يرتكب ضد سلامة أقاليمها، أو استقلالها السياسي، شريطة أن يكون
استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسباً معه، ويتوقف حيث
يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين»(22).
هذا الحق الذي يقرره القانون الدولي يتوافق مع
ما جاء به الإسلام من حق الدفاع وصد العدوان والذي طبق في أغلب الحروب الإسلامية
ضمن القواعد الشرعية. إلا أن ما جاء في القانون الدولي يجيز التدخل في شؤون الغير
ويجعل الحرب «مشروعة للسلامة الجماعية وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، هو مشروع أيضاً
دفاعاً عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقليات من رعاياها»(23). وفي هذا رد على من يطعن في الإسلام
ويتهمه في أنه يتدخل في شؤون الغير، وأنه في ذلك يتجاوز حق الدفاع الشرعي، بينما
هو مباح أيضاً في القانون الدولي الذي توسع كثيراً في معنى "العدوان"،
بغية تحقيق مصالح عديدة اقتصادية وسياسية وعسكرية وغير ذلك، بينما نجد أن الشريعة
الإسلامية لم تبح ذلك إلا لتامين مصلحة الدعوة الإسلامية. ولإيضاح مدى توسع
القانون الدولي في مبررات الحرب دولياً نستعرض أبرز الأهداف التي تبيحها:
1- تباح
الحرب لتحقيق أهداف سياسية:
تسعى
الدول الكبرى للمحافظة على مصالحها السياسية بإقامة علاقات سياسية مع الدول الفقيرة
والضعيفة، وذلك بدعم حكومات معينة وإيصالها إلى الحكم لتكون تابعة لها وتحقق لها
أهدافها، وتمكن من خلالها بسط نفوذها على دولها. وإذا ما حاولت شعوب تلك الدول
التخلص من حكوماتها العميلة واستبدالها قامت تلك الدول الكبرى بخوض حرب ضدها
واحتلالها عسكرياً، كاحتلال الاتحاد السوفييتي (سابقاً) لأفغانستان. وقد تكون
الحرب للدفاع عن استقلال سياسي أو للتخلص من استعمار عسكري لإقامة كيان سياسي
مستقل، كالحروب التي خاضتها شعوب الدول العربية ضد مستعمريها لنيل استقلالها في
القرن الماضي.
2-
تباح الحرب للدفاع عن المصالح الاقتصادية:
إن
الدول تسعى نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي لشعوبها، وفي حال تعرض مصالحها
الاقتصادية للخطر تصبح الحرب ضرورة للمحافظة عليها، ويجوز لها التدخل في شؤون دولة
أخرى. وأمثلة ذلك كثيرة فالحرب التي تعرضت لها البلاد العربية في نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين تبرز بشكل جلي التنافس الاستعماري لنهب ثروات
الأمة بكاملها، وإفقار شعبها من أجل أن تحيا شعوب الدول الاستعمارية، ويزدهر
اقتصادها، وكل ذلك كان في ظل القانون الدولي ، وتحت أسماء عديدة دخلت جيوش
المستعمرين هذه البلاد وشنت الحروب ضدها، فمرة كانت انتداباً ومرة كانت وصاية،
ومرة كانت حماية، وكلها تحمل الطابع الاستعماري نفسه، وتظهر الصراع القوي بين
الدول الكبرى من فرنسية وبريطانية للمحافظة على مصالحها الاقتصادية. ولا يخفى
الدافع الاقتصادي في الحروب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من أفغانستان
والعراق بحجة مكافحة الإرهاب وذرائع أخرى واهية.
3- تباح
الحرب لتحقيق أهداف عسكرية:
شنت
الحرب العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بهدف نزع أسلحة الدمار
الشامل العراقية والتي لم يثبت وجودها أصلاً، وذلك بمباركة القانون الدولي
وموافقته، بحجة أن هذه الأسلحة تهدد السلم والأمن الدوليين!!.
4- تباح
الحرب لتحقيق مصالح تجارية:
أحدثت الثورة الصناعية في العالم الغربي أزمة
في البحث عن المواد الأولية لصناعته ومشكلة في تأمين الأسواق لتصريف بضاعته. وهذه
المشكلة مازالت مستمرة، وقد دفعت كثيراً من الدول لشن الحرب من أجل المحافظة على
تجارتها وتأمين الأسواق لها كتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شن حرب على
فيتنام، والرحب في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وحصار كوبا...دفاعاً عن
مصالحها وأغراضها، وكذلك احتلال بريطانيا للهند تأميناً للتوابل، ولمصر لتأمين
القطن، وللعراق للمحافظة على طريق الهند، وجعل تلك البلدان سوقاً لتجارتها.
هذه
الأهداف التي ذكرناها هي أهداف مشروعة في القانون الدولي، أما الأهداف غير
المشروعة للحرب الدولية فهي كثيرة، كحب السيطرة والاستعلاء وسلب ثروات الأمم وقهر
الشعوب، وإن كانت هذه محرمة في القانون الدولي إلا إنها صفة بارزة تتسم بها، ولم
يستطع القانون الدولي منعها. واحتلال اليهود لفلسطين مثال صارخ على ذلك.
فالحرب
لدى رجال القانون الدولي يلجأ إليها لأغراض مادية تدعو إليها مصلحة الدولة التي
تعلنها على غيرها بمحض تقديرها، وفي سبيل نفعها الذاتي القائم على الهوى وحب
التسلط وتدعيم الاقتصاد. ويجمل بعض الباحثين وظائف الحرب المشروعة وغير المشروعة
في الآتي:
«1-
التدمير الديموغرافي والاقتصادي لحياة البشر والثروات المادية والنشطات من كل
الأنواع.
2- المقامرة
للحصول على أرباح كبيرة مقابل خسائر محدودة بالاعتماد على احتمال كبير في النجاح.
3- المزج
بين اللعب والمغامرة.
4- تعديل
التوازن السياسي الداخلي والدولي.
5- تغيير
البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
6- تجربة
الأسلحة والعتاد والتقنيات والتكتيكات الحديثة. وقد كان للحرب النووية بمجرد
التهديد بها وحده تأثير كبير على جميع الوظائف السابقة»(24).
إذا
كان هذا هو واقع الحرب في القانون الدولي وأهدافها، فإن الجهاد في الفقه
الإسلامي، باختصار، لا يكون إلا في حالات
تتطلبها الدعوة الإسلامية، والتي لا تخرج عن كونها استعمالاً لحق من حقوق الدولة
الطبيعية المعترف بها في القانون الدولي المعاصر. وهي حق البقاء، وحق الدفاع
الشرعي، وحق المساواة وحق العيش بحرية، وحق الاحترام المتبادل. وهذه الحالات كلها
تبرر مشروعية الباعث على القتال في الإسلام الذي حدد بوجود عدوان على المسلمين،
ولا يفهم من كلمة "عدوان" هو أن يكون المسلمون في حالة سلبية مطلقة لا
يتحركون لخوض غمار المعركة إلا بعد أن تشن الحرب عليهم، وإنما قد يكون لهم دور
إيجابي في البدء بالقتال عند توافر مقتضياته وظروفه، كما أن حق الدولة بالحرية
لشعبها ولرعاياه يخولها حق للدفاع عنهم.
خامساً
: أنواع الحرب في القانون الدولي:
من
خلال أهداف الحرب قسم القانون الدولي الحرب إلى حروب مشروعة وحروب غير مشروعة. أما
الأولى فيقصد بها الحروب الدفاعية التي تخاض في سبيل الدفاع عن حقوق الدولة
المعترف بها في القانون أو لتحقيق مبادئ إنسانية في التدخل لرفع الظلم عن الآخرين.
أما الثانية فيقصد بها الحرب التي تخاض في سبيل الاستعلاء والاغتصاب والاستيلاء
ونهب ثروات الآخرين، وتحقيق مكاسب مادية أو سياسية أو اقتصادية. ولهذا نجد أن
التقسيم المذكور يقسم أيضاً كل قسم إلى قسمين:
أما
الحرب المشروعة تنقسم إلى:
1-
الحرب الدفاعية: «وهي حق يقرره
القانون الدولي للدولة أو لمجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال يرتكب ضد
سلامة إقليمها، أو استقلالها السياسي، شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة
الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسباً معه، ويتوقف حيث يتخذ مجلس الأمن التدابير
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين»(25).
2-
الحرب الوقائية: وهي حق يقرره القانون
الدولي للدولة أو لمجموعة دول بشن الحرب ضد اعتداء يبيت لها يتناول سلامة أراضيها
وأمنها الداخلي والخارجي، أو مصالحها المعترف بها في القانون الدولي، وذلك بغية صد
الاعتداء والقضاء عليه في مكمنه.
أما
الحرب غير المشروعة فهي نوعان:
1- الحرب
الهجومية:
هي حرب غير مشروعة في القانون الدولي تشنها الدولة أو مجموعة دول بهدف الظلم
والاستعلاء والاستيلاء والسيطرة على الآخرين واستعبادهم، وذلك من أجل تحقيق مكاسب
مادية أو معنوية تعود بالنفع على شعوبها على حساب الآخرين.
2- الحرب
العدوانية: فسرت "مؤسسة هارفارد" العدوان بأنه : «اللجوء إلى القوة
المسلحة من قبل دولة، عندما يتقرر اللجوء إلى القوة المسلحة بوسائل تلتزم الدولة
بقبولها، لتشكل انتهاكاً لأحد الالتزامات والواجبات»(26). لذلك اعتبرت محكمة العدل الدولية في
"نورمبرج" أن إعلان حرب عدوانية يشكل جريمة دولية بل إنها تشكل أكبر
جريمة دولية تحوي في مضمونها مجمل الشروط المتراكمة.
كما
يمكن حصر هذا التقسيم لأنواع الحرب في نوعين اثنين فقط هما: الحرب الدفاعية،
والحرب العدوانية. لأن الحرب الدفاعية تشتمل على الحرب الوقائية، وكذلك الحرب
العدوانية تشتمل الحرب الهجومية. والحرب العدوانية تبيح للطرف الآخر صد هذا
العدوان. وقد حدد معنى العدوان الذي يبيح للمسلمين التصدي له بأنه «حالة اعتداء
مباشر وغير مباشر على المسلمين وأموالهم وبلادهم، بحيث يؤثر في استقلالهم
واضطهادهم وفتنتهم عن دينهم، أو تهديد أمنهم وسلامتهم ومصادرة حرية دعوتهم، أو
حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين، بحيث يعتبر خطراً محققاً، أو يتطلبون
حذراً أو احتياطاً»(27). وليس
هذا التحديد لمعنى العدوان إسلامياً فيه توسع كبير، وبخاصة أن الجمعية العامة في
الأمم المتحدة قد ذهبت إلى أكثر من هذا المعنى في (21) ديسمبر (1946) عندما طلبت
من لجنة القانون الدولي دمج مبادئ محكمة "نورمبرج" وأحكامها في مشروع
قانون دولي لجرائم الحرب. هذا وقد وضعت هذه اللجنة مشروع قانون الإساءات ضد الجنس
البشري وسلامته، وفي سنة (1954) حددت الإساءات التالية التي تدخل تحت مفهوم
العدوان:
1- أعمال
العدوان، بما في ذلك استعمال القوة المسلحة لأغراض الدفاع الوطني أو الجماعي
الذاتي.
2- تهديد
من قبل سلطات إحدى الدول باللجوء إلى العدوان ضد دولة أخرى.
3- الاستعداد
لاستعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى لأغراض لا علاقة لها بالدفاع الوطني أو
الجماعي.
4- تنظيم
وتشجيع واحتمال الفرق المسلحة التي تعمل ضد دولة أخرى.
5- انتهاك
شروط المعاهدات التي تقيد التسلح، والتدريب العسكري والتحصينات ...إلخ.
6- ضم
الأراضي التابعة لدولة أخرى أو الأراضي الواقعة تحت نظام دولي بطرق تتعارض مع
القانون الدولي.
7- تجهيز
وإثارة الحرب الأهلية في دولة أخرى.
8- التدخل
في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى عن طريق الضغط الاقتصادي أو السياسي
للحصول على فوائد مهما كان نوعها.
ففي
هذا التعداد في القانون الدولي توسع في معنى العدوان الذي يبيح قيام الحرب لأتفه
الأسباب وأخسها بغية تحقيق مآرب سياسية واقتصادية وعسكرية، وهذا غير موجود في
الجهاد الإسلامي الذي هو وسيلة في يد ولي الأمر لحماية المسلمين والدفاع عنهم وعن
حقهم في حرية ممارسة دعوتهم ونشرها. أما في القانون الدولي برغم عدم اعترافه
بالحرب العدوانية، واعتبارها غير مشروعة إلا أنن نجد أن جميع أنواع الحرب المذكورة
موجودة على أرض الواقع ولم ينجح نظام الأمن الجديد نظرياً أو عملياً، في تحريم
الالتجاء إلى القوة المسلحة أو في وضع قواعد جديدة تنظمها أو تحد من أخطارها وتبقى
الحرب نوعاً واحداً هي الدمار للإنسان وللبنيان وتبقى مستمرة تحمل شروراً وأوزاراً
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
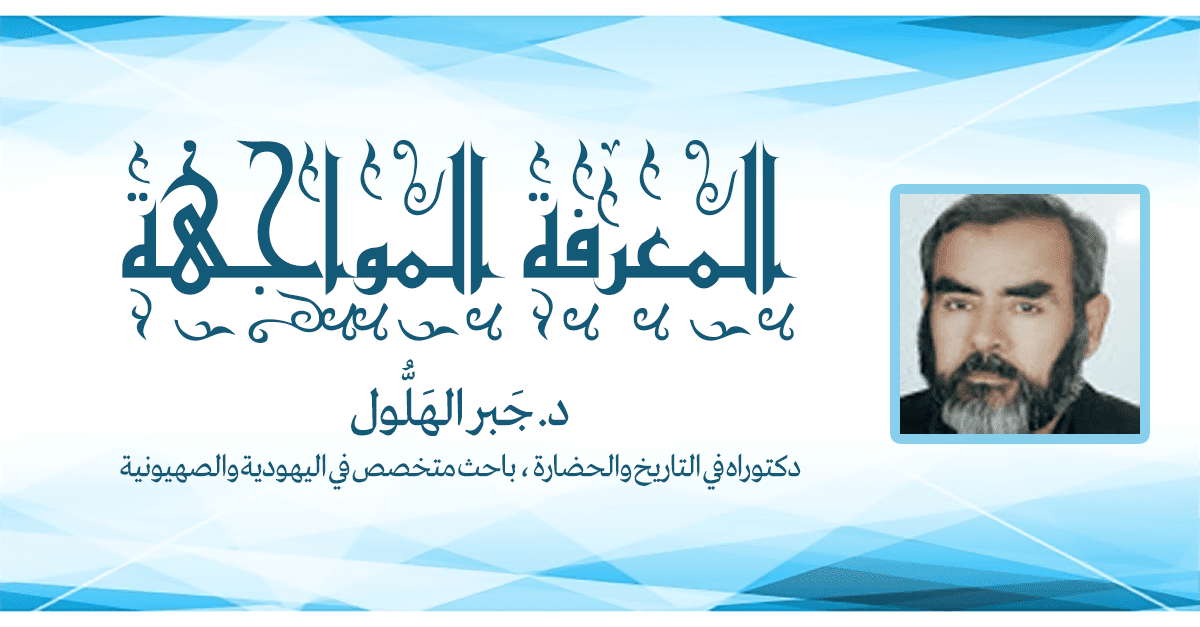
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات