أنواع
الحرب في الفكر الإسلامي
والقانون
الدولي
الدكتور
جبر الهلّول
قسم ابن خلدون الحرب
إلى أربعة أنواع تبعًا لأهدافها وذلك في قوله: «اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم
تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض،
ويتعصب لكل منها أهل عصبيته فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب
الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب – وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا
جيل- وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما غيرة أو منافسة وإما عدوان وإما غضب لله
ودينه وإما غضب للملك وسعيه في تمهيده، فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة
والعشائر المتناظرة والثاني وهو العدوان... والثالث هو المسمى في الشريعة الجهاد،
والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها، فهذه أربعة أصناف من
الحروب الأولان منها حروب بغي وفتنة، والصنفان الأخيران حرب جهاد وعدل»[1].
فقد قسم ابن خلدون الحرب
إلى حرب مشروعة وغير مشروعة، وبما أن الحروب في الإسلام هي دومًا مشروعة خلافًا
للحروب غير المسلمة فلذلك الحروب المشروعة عند ابن خلدون هي الجهاد في سبيل الله،
والثاني توطيد الأمن في الدولة بمحاربة الخارجين عليها من البغاة والعصاة.[2]
والملاحظ
أن العلماء المعاصرين من المسلمين لم يخرجوا عن تقسيم ابن خلدون للحرب تبعًا
لأغراضها، إلا أنهم لم يتفقوا تمام الاتفاق مع تقسيم القانون الدولي للحرب الذي
قسمها إلى حرب مشروعة وغير مشروعة، على نحو ما يلي:
1-
الحرب الدفاعية.
2-
الحرب الوقائية.
3-
الحرب العدوانية.
4-
الحرب الهجومية.
ومنهم من اختصر
التقسيم المذكور إلى حرب دفاعية وحرب عدوانية أو هجومية[3].
إلا أن "وهبة الزحيلي" في كتابه "آثار الحرب" قد رأى أولًا:
أن هذا التقسيم الدولي لا ينطبق على فكرة الجهاد في الإسلام، لأن الإسلام لا يؤمن
بحدود وطن قومي، حتى يلتزم سكانه الدفاع عنه فقط، فنطاق الإسلام واسع، والجهاد فرض
لحماية الدعاة إليه في كل مكان، إذا توفرت القوة طبعًا، وأما التقسيم المذكور فهو
منسجم مع النظام الإقليمي للدولة الحديثة.
ثانيًا: أنه لم يعد
هناك أهمية لهذا التقسيم عند فقهاء القانون الدولي، لأن الشواهد التاريخية تؤكد
لنا نقضه وتحديه، فكثيرًا ما يدعي دعاة الحرب أنهم يحاربون عن مصالحهم بعد أن
تحرشوا بخصومهم ودفعوهم إلى اعتداء ما[4].
ولهذا لم يحصر "وهبة الزحيلي" أوجه مشروعية الجهاد بما يسمى بحالات "الدفاع
الوقائي".
كذلك
"عبد التواب مصطفى" رفض تطبيق التقسيم المذكور في القانون الدولي على
الجهاد الإسلامي في كتابه "العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في
الإسلام" حيث قال فيه: «..لا معنى لتقسيم الجهاد في سبيل الله إلى حرب دفاعية
وأخرى هجومية، إذ مناط الجهاد في سبيل الله ليس هو الدفاع لذاته والهجوم لذاته،
إنما مناطه الحاجة إلى إقامة المجتمع الإسلامي بكل ما يتطلبه ذلك من النظم
والمبادئ والوسائل، ولا عبرة بعد ذلك بكون الجهاد دفاعًا أو هجومًا»[5].
والملاحظ أن "عبد التواب مصطفى" لم يفرق بين الدفاع والهجوم إلا من
ناحية واحدة ألا وهي البدء في القتال، فمن يبدأ يكون مهاجمًا ومن يرد يكون مدافعًا،
وذلك عند تعريفه "الهجوم الدفاعي" بقوله: «أي أن يهجموا مدافعين على
تكتلات الأعداء التي تستعد للزحف على المسلمين وكانت هذه هي خطة المسلمين بعد ذلك
فيما قاموا به من حروب»[6].
إلا أن "وهبة
الزحيلي" كان له رأي مخالف في معنى الحرب الهجومية من جوابه على السؤال هل
الجهاد هو عمل دفاعي أم هجومي؟ بقوله: «فهذا تقسيم لا ينطبق على نظام الجهاد
الإسلامي، لأن الإسلام لا يؤمن بالحروب الحديثة- حروب المطامع البشرية – التي أملت
مثل هذا التقسيم. ولا يصح أن يوصف الجهاد بأنه هجومي لأن الهجوم يعنى الظلم،
والجهاد عدل في الواقع، وقد يكون الجهاد مطلوبًا إذا استبد الحكام بمصالح رعاياهم،
وهنا يظهر المسلمون بأنهم دعاة إصلاح عام وجند رسالة يبلغونها للناس على بينة
وهدى، رغم معاندة بعض الظالمين. وقد يلتزم المسلمون جانب الدفاع فقط دون التقيد
بحدود جغرافية مصطنعة فالإسلام لا تحده حدود»[7].
وفي السياق نفسه رأى "محمد اللافي" في كتابه "نظرات في أحكام الحرب
والسلم" أن الجهاد في الإسلام لا يمكن أن يوصف بأنه هجومي لأن الهجوم يعني
الظلم. بينما الجهاد يهدف إلى منع الظلم ونصرة المستضعفين.
أما "محمود حسن
أحمد" في كتابه "العلاقات الدولية في الإسلام" فإنه أخذ من التقسيم
الدولي الحديث للحرب الجانب المشروع منه، عندما قال: «الحرب غير مرغوبة لذاتها في
الإسلام، ولكنها تصبح فرضًا لصد العدوان عنه عند حدوثه أو عند الإعداد له والشروع
فيه. فالنوع الأول يعرف بالحرب الدفاعية والثاني يعرف بالحرب الوقائية»[8].
كما أن "علي علي
منصور" رأى: أن الحرب المشروعة في الإسلام هي الحرب الدفاعية وينطوي تحتها
نوعان: أولهما الدفاع عن النفس وفيه يقول الكتاب المجيد: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله
على نصرهم لقدير}[9]، وثانيهما: الإغاثة
الواجبة لشعب مسلم أو حليف عاجز عن الدفاع عن نفسه[10]،
وفيه يقول القرآن الكريم: {وما
لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من
لدنك نصيرًا}[11]. إلا أن بعض
الباحثين المعاصرين قد توسعوا في ذلك فأخذوا بالتقسيم الحديث في القانون الدولي،
وقسموا الحروب الإسلامية طبقًا لذلك. ومثال ذلك "إحسان الهندي" في كتابه
"الإسلام والقانون الدولي" الذي قال فيه: «إذا جاز لنا تقسيم الحروب إلى
أربعة أنواع: عدوانية وهجومية ووقائية ودفاعية، فيمكننا أن نقول من دون تردد: إن
حكم الإسلام فيها هو أنه يحظر الحروب العدوانية في جميع الأحوال، ويسمح بالحروب
الهجومية إذا كانت فيها مصلحة إسلامية عليا، ويحض على الحروب الوقائية، بينما يرفع
الحروب الدفاعية إلى مرتبة الواجب الديني الذي يكلف فيه كل مسلم مهما كانت قدرته
وسنه ومنزلته الاجتماعية»[12].
بعد استعراض هذه
الآراء أجد أن الحرب تنقسم إلى قسمين: حرب مشروعة وغير مشروعة. فالمشروعة هي الحرب
الدفاعية وغير المشروعة هي الحرب العدوانية، وأن الجهاد في الإسلام مشروع في كل
أحواله، ولهذا لا يجيز إلا الحرب الدفاعية التي تقتضيها حماية الدعوة الإسلامية،
وأمان استمرارها وانتشارها إلى قيام الساعة.
أما بالنسبة إلى
أنواع الحرب في القانون الدولي فإننا نجدها قد قسمت إلى حروب مشروعة وحروب غير
مشروعة، أما الأولى فيقصد بها الحروب الدفاعية التي تخاض في سبيل الدفاع عن حقوق
الدولة المعترف بها في القانون أو لتحقيق مبادئ إنسانية في التدخل لرفع الظلم عن
الآخرين. أما الثانية فيقصد بها الحروب التي تخاض في سبيل الاستعلاء والاغتصاب
والاستيلاء ونهب ثروات الآخرين، وتحقيق مكاسب مادية أو سياسية أو اقتصادية. ولهذا
نجد أن التقسيم المذكور يقسم كل قسم إلى قسمين:
أولًا: الحروب
المشروعة تنقسم إلى:
1-
الحرب الدفاعية: وهي حق يقرره
القانون الدولي للدولة أو لمجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال يرتكب ضد
سلامة إقليمها، أو استقلالها السياسي، شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة
الوحيدة لدرء ذلك العدوان ومتناسبًا معه، ويتوقف حيث يتخذ مجلس الأمن التدابير
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين[13].
2-
الحرب الوقائية: وهي حق يقرره
القانون الدولي للدولة أو لمجموعة دول بشن الحرب ضد اعتداء يبيت لها يتناول سلامة
أراضيها وأمنها الداخلي أو الخارجي أو مصالحها المعترف بها في القانون الدولي،
وذلك بغية صد الاعتداء والقضاء عليه في مكمنه.
ثانيًا: الحرب غير
المشروعة: تنقسم إلى:
1-
الحرب الهجومية: هي حرب غير مشروعة
في القانون الدولي تشنها الدولة أو المجموعة دول بهدف الظلم والاستعلاء والاستيلاء
والسيطرة على الآخرين واستعبادهم، وذلك من أجل تحقيق مكاسب مادية أو معنوية تعود
بالنفع على شعوبها على حساب الآخرين.
2-
الحرب العدوانية: بحسب مؤسسة
"هارفارد" التي فسرت العدوان بأنه: «اللجوء إلى القوة المسلحة من قبل
دولة، عندما يتقرر اللجوء إلى القوة المسلحة بوسائل تلتزم الدولة بقبولها، لتشكل
انتهاكًا لأحد الالتزامات والواجبات»[14].
ولذلك اعتبرت محكمة
الحرب الدولية في "نورمبرج" أن إعلان حرب عدوانية يشكل جريمة دولية بل
إنها تشكل أكبر جريمة تحوي في مضمونها مجمل الشروط المتراكمة[15].
بعد هذا التعداد
لأنواع الحرب في القانون الدولي يمكن حصرها في نوعين اثنين فقط هما: الحرب
الدفاعية والحرب العدوانية. لأن الحرب الدفاعية تشمل الحرب الوقائية، وكذلك الحرب
العدوانية تشمل الحرب الهجومية.
وهنا لابد من تحديد
معنى العدوان الذي يبرر القتال، ففي الإسلام هو بحسب تعريف "وهبة
الزحيلي": «حالة من اعتداء مباشر وغير مباشر على المسلمين وأموالهم وبلادهم،
بحيث يؤثر في استقلالهم واضطهادهم وفتنتهم عن دينهم، أو تهديد أمنهم وسلامتهم
ومصادرة حرية دعوتهم، أو حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة للمسلمين بحيث يعتبر
خطرًا محققًا أو يتطلبون حذرًا أو احتياطًا»[16].
وإلى هذا المعنى ذهبت
الجمعية العامة في الأمم المتحدة في (21) ديسمبر (1946) عندما طلبت من لجنة
القانون الدولي دمج مبادئ ميثاق محكمة "نورمبرج" وأحكامها في مشروع
قانون دولي لجرائم الحرب. وقد وضعت هذه اللجنة مشروع قانون الإساءات ضد الجنس
البشري وسلامته. وفي سنة (1954) حددت الإساءات التالية بأنها متعلقة بقضية "العدوان":
«1- أعمال العدوان،
بما ذلك استعمال القوة المسلحة لأغراض الدفاع الوطني أو الجماعي الذاتي.
2- تهديد من قبل
سلطات إحدى الدول باللجوء إلى العدوان ضد دولة أخرى.
3- الاستعداد
لاستعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى لأغراض لا علاقة لها بالدفاع الوطني أو
الجماعي.
4- تنظيم وتشجيع
واحتمال الفرق المسلحة التي تعمل ضد دولة أخرى.
5- تجهيز وإثارة
الحرب الأهلية في دولة أخرى.
6- انتهاك شروط
المعاهدات التي تقيد التسلح، والتدريب العسكري والتحصينات...إلخ.
7- ضم الأراضي التابعة
لدولة أخرى أو الأراضي الواقعة تحت نظام دولي بطرق تتعارض مع القانون الدولي.
8- التدخل في الشؤون
الداخلية والخارجية لدولة أخرى عن طريق الضغط الاقتصادي أو السياسي للحصول على
فوائد مهما كان نوعها»[17].
ويلاحظ في هذا
التعداد توسع القانون الدولي" في تحديد معنى "العدوان" مما يبيح
الحرب لأتفه السباب وأخسها، بغية تحقيق مآرب سياسية واقتصادية وعسكرية، وهذا غير
موجود في مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي الذي هو «وسيلة في يد ولي الأمر لحماية
نشر الدعوة أو الدفاع عن المسلمين»[18].
كما ويلاحظ على القانون الدولي بالرغم من عدم اعترافه بالحرب العدوانية، واعتبارها
غير مشروعة، إلا أننا نجد أن جميع أنواع الحرب المذكورة موجودة على أرض الواقع،
ولم ينجح نظام الأمن الجديد نظريًا أو عمليًا في تحريم الالتجاء إلى القوة المسلحة،
أو في وضع قواعد جديدة تنظمها، أو تحد من أخطارها، وبخاصة أن أول من يخترقها على
الدوام هم الدول الكبرى التي كان يفترض بها أن تشرف أو تساعد بشكل مباشر وغير
مباشر في تطبيق القانون الدولي.
[1]
- ابن خلدون: المقدمة، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1983. ص175.
[2]
- د. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام، ط4، مؤسسة
الرسالة، بيروت، 1989. ص 37.
[3]
- محمد اللافي: نظرات في أحكام الحرب والسلم، دراسة مقارنة، ط1،
دار اقرأ، ليبيا ،1989. ص
[4]
- وهبة الزحيلي: آثار الحرب، ط4، دار الفكر، دمشق، 1992. ص93-94.
[5]
- عبد التواب مصطفى: العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في
الإسلام، ط1، الملتقى للإنتاج الفني والثقافي، مصر، 1994. ص116.
[6]
- المرجع نفسه، ص115.
[7]
- وهبة الزحيلي: آثار الحرب، ص 124-125.
[8]
- محمود حسن أحمد: العلاقات الدولية في الإسلام، ط1، دار الثقافة
العربية، الشارقة، 1996. ص83-84.
[9]
سورة الحج: الآية (39).
[10]
- علي علي منصور الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، دار
القلم، مصر، لات تاريخ. ص 286.
[11]
- سورة النساء: الآية (75).
[12]
- إحسان الهندي: الإسلام والقانون الدولي،ط2ن دار طلاس، دمشق،
1998. 122.
[13]
- محمد اللافي: المرجع السابق، ص 109.
[14]
- المرجع نفسه، ص 100.
[15]
- المرجع نفسه، 91.
[16]
- وهبة الزحيلي: آثار الحرب، ص91.
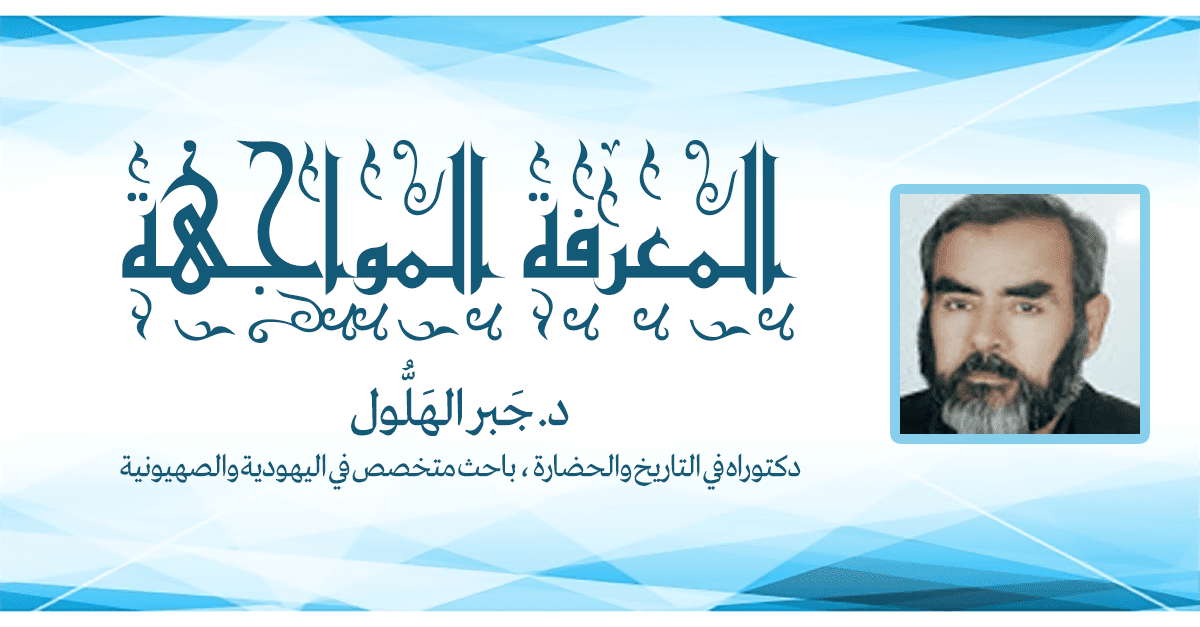
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات