قراءة
في المراحل التأسيسية للمشروع اليهودي الصهيوني
الدكتور جبر الهَلّول
-
المخلص:
أُقدم في هذا البحث
قراءة موجزة لأهم المراحل التي مر به المشروع الصهيوني قبل الإعلان عن قيامه عام
1948، وذلك لأهمية الوقوف عند تلك المراحل بالنسبة لهذا المشروع، ودور الفكر
الديني والسياسي المسيحي واليهودي في صناعتها، ولنؤكد على خطورة دور المحرك
الأساسي في أحداث التاريخ - سواء كان هدفًا أو وسيلة - ألا وهو الدين من خلال هذا
المشروع الذي بتنا نعيشه كواقع عملي في المنطقة، ويفرض علينا مقاومته تحت عنوان:
"المعرفة المُواجِهة".
البحث:
إن المشروع الصهيوني
لم يأت وليد المصادفة والمفاجأة، أو كما يقال
صنع على غفلة من الزمن، وبالتالي لم يكن إعلان قيام
"دولة إسرائيل" عام (1948)
هو المرحلة الأولى من بناء المشروع الصهيوني، وإنما سُبق بمراحل تأسيسية طويلة،
تبلور في نهايتها المشروع الصهيوني كفكرة وحركة ودولة اتضحت معالمها في عقلية كبار
الشخصيات اليهودية الذين اعتمدوا على الخطوات التأسيسية التي مر بها المشروع
الصهيوني تاريخيًّا قبل الانتقال به إلى مرحلة التثبيت والترسيخ في المنطقة
العربية عن طريق الحرب والاعتماد على مبدأ القوة النوعية المتفوقة التي ربطت مصيره
وجودًا وعدمًا بها.
فالمشروع الصهيوني
كأي مشروع خطير وكبير لم ينفصل عن عامل الزمن في حركته ومُحرِّكه الديني عندما أخذ
سياقه التاريخي في عملية البناء التي كان لابد لها أن تمر بمراحل تراكمية متسلسلة
لإنجازه والتي سأوجزها في مراحل ثلاث.
-
المرحلة الأولى: ظهور
الإرهاصات والدعوات لعودة اليهود إلى فلسطين:
ترجع
بدايات هذه المرحلة إلى ظهور إرهاصات الفكر الصهيوني، والدعوة إلى تهجير اليهود
إلى فلسطين، وبناء "وطن قومي" لهم وذلك في القرن السادس عشر عندما تسربت
مبادئ وعقائد جديدة إلى حياة الغرب المسيحي مع انتشار المذهب
"البروتستانتي" في أوروبا. حيث كان من أهم هذه العقائد: "عقيدة
الألفية" التي تؤمن بأن المسيح لا بد أن يعود على رأس الألفية الجديدة، وأن
ذلك لن يتم إلا بعد تجميع غالبية اليهود من جميع أنحاء العالم في فلسطين، وقيامهم
بإعادة بناء "هيكل سليمان" التاريخي مرة أخرى وأخيرة في مدينة القدس.
إن جوهر عقيدة الإيمان "بالعصر الألفي
السعيد" مرتبط بتجميع اليهود بفلسطين، واعتناقهم المسيحية كشرط لعودة المسيح،
وإعلان نهاية الزمن أو نهاية التاريخ!.
لقد تركز انتشار عقيدة
الخلاص والتفكير في آلية الترجمة العمليّة لها عن طريق ارتباطها بعودة اليهود إلى
فلسطين والتي جاءت مع حركة الإصلاح الديني في بريطانيا مع نهاية القرن السادس عشر،
لاسيما على يد عالم اللاهوت اليهودي "توماس برايتمان" (1562 – 1607) الذي
تكلم بشكل مفصل في كتاب له عن البعث اليهودي من خلال عودة اليهود إلى فلسطين. وكان
بذلك الطرح مُلْهِمًا لكثير من أتباعه ومنهم البرلماني الإنكليزي القانوني
"هنري فنش" الذي وافق على ما طرحه "برايتمان" ونشر كتابه
"البعث العالمي الكبير، أو عودة اليهود" عام (1621)، وقد جاء فيه: «ليس
اليهود قلة مبعثرة، بل إنهم أمة. ستعود أمة اليهود إلى وطنها، وستُعمّر زوايا
الأرض.. وسيعيش اليهود بسلام في وطنهم إلى الأبد»([1]).
إن ما طرحه
"فنش" في زمانه يُعد طرحًا جديدًا، ويُعتبر الأول من نوعه، فقد مزج بين
الرؤى الدينية والسياسية بشكل واضح، نتيجة تأثير حركة الإصلاح الديني التي أخذت
تشق طريقها في المجتمع الغربي ليس بين رجال الدين وحسب، وإنما بين رجال القانون
والسياسة أيضًا. وكان اليهود المستفيدين الوحيدين منها، لاسيما فيما يتعلق بتدرج
تغيير نظرة عدم قبول المجتمع المسيحي التاريخية لهم، وتخفيف تحميلهم خطيئة ووزر قتل
المسيح، ودعوتهم للتوبة للتكفير عن ذلك، ودعاهم "هنري فنش" صراحة إلى
ذلك بقوله: «إن الله وهو يتغاضى عن أيام خطيئتكم يدعوكم بكل وسيلة للتوبة، وهدفه
أن يجمعكم من كل الأماكن التي تفرقتم فيها شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وأن يُعيدكم
إلى وطنكم، ويضمكم إليه عن طريق الإيمان إلى الأبد»([2]).
فمن خلال طرح هذه الأفكار أصبحت فكرة إعادة
فلسطين إلى اليهود "وطنهم التاريخي" الذي أُبعدوا عنه شائعة في إنجلترا.
وارتبطت هذه الفكرة دينيًّا بالفكر المسيحي البروتستانتي الذي يعتقد أن عودة
اليهود إلى فلسطين هو المقدمة الحتمية لعودة المسيح المنتظر تبعًا لنبوءات الفكر
الديني اليهودي([3]).
وتطورت هذه الفكرة عام (1649) إلى إرسال استرحام للحكومة الإنكليزية جاء فيه «ليكن
شعب إنجلترا وسكان الأراضي المنخفضة، من يحمل أبناء وبنات إسرائيل على سفنهم إلى
الأرض التي وُعِد بها أجدادهم إبراهيم وإسحق ويعقوب لتكون إرثهم الأبدي»([4]).
إنه من خلال الاطلاع
على هذا السياق التاريخي لتطور عقيدة العصر الألفي لدى البروتستانت، ندرك جوهر المناخ
الديني والسياسي الذي جاء به وعد بلفور لاحقًا بإعطاء اليهود وطنًا قوميًّا لهم في
فلسطين، ولماذا احتضنت بريطانيا ومن ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هذا
المشروع.
وتجدر الإشارة هنا إلى
أن قانون "التولية"([5])
للتاج البريطاني نص منذ عام (1701) على أن يكون التاج بروتستانتيًّا، وتَعَدَّ ذلك
إلى الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقًا من دون أن يُنَص على ذلك دستوريًّا، حيث
كان رؤساء أمريكا بعد إعلان الاستقلال عام (1776) عن بريطانيا من البروتستانت - أي
من الرئيس الأول جورج واشنطن وحتى الرئيس الحالي "ترامب" - باستثناء
الرئيس "جون كينيدي" الذي كان كاثوليكيًّا وقُتل بعد ثلاث سنوات من
تسلمه الحكم عام (1963) ولم يُكشف بعد عن ملف تحقيقات اغتياله!.
وبالعودة إلى العنصر
الأساسي لجوهر الفكر الخلاصي الذي يتعلق بالبعث اليهودي وإعادة توطينهم في فلسطين،
نلاحظ أن السياسة لعبت دورًا مهمًّا في تهيئة الظروف لذلك لاسيما عندما دعا
"أوليفر كرومويل"([6])
إلى مؤتمر "وايت هول" عام (1655) لبحث مشكلة السماح بعودة اليهود إلى
بريطانيا من أجل الإقامة في بلد مسيحي أولًا كخطوة عملية لتحقيق فكرة عودة اليهود
إلى فلسطين، ومقدمة لابد منها لعودة المسيح المنتظر وفق العقيدة الدينية البروتستانتية!.([7])
وضمن
السياق التاريخي لفكرة العصر الألفي التي تركزت في بريطانيا، وانتشرت في عموم
أوروبا بين معتنقي البروتستانتية، كان لفرنسا نصيبها من هذا الفكر الخلاصي الذي
تركز في المناطق الجنوبية منها، وبخاصة على يد ممثلهم "إسحق دي لابيرير"
الذي دعا في كتابه "دعوة اليهود" إلى توطين اليهود في فلسطين([8]).
لكن هذه الفكرة لم تُحقق نجاحًا في فرنسا كما في بريطانيا، وإن كان هناك عدد من
الباحثين من اعتبر أن أول تحالف حقيقي بين الهوس الديني اليهودي
"الألفي" وحُمّى الاستعمار الغربي المسيحي كان عندما دعا "نابليون"([9]) في بيان أصدره عام (1799) أثناء فرضه الحصار
على عكا يهود العالم إلى القتال معه من أجل إعادتهم إلى فلسطين "أرض
الأجداد" وبناء مملكتهم الدينية القديمة فيها. ([10])
هذا النداء اللافت في
مضمونه، وأهمية الشخص الذي نسب إليه، دفع عدد من الباحثين إلى الوقوف عنده والنظر
فيه، فشككوا بعدم صحته، واثبتوا بأن ولا وجود له في أي مصدر تاريخي موثوق، وبخاصة لم
يعثروا على نصه الأصلي في أي مركز من مراكز التوثيق المعتبرة، ولا في محفوظات
الدولة الفرنسية ووزاراتها المعنية، بل تبيّن، بعد البحث، أن هذا النداء اختراع
صهيوني خالص، روّجه عدد من الكتّاب اليهود الصهيونيين([11])
الذي وصل الأمر بهم كـ"حاييم وايزمان" بأن يصف نابليون: «بأنه
أول الصهيونيين الحديثيين غير اليهود»([12]).
فالزعم والترويج لهذا البيان من قبل
الكتاب اليهود الصهيونيين، والثناء على نابليون لا شك كان له أهدافه، حيث كان من
المنطقي أن لا يكون هذا البيان صحيحًا –أو على الأقل يُشكك به - لأن نابليون وإن
تأثر بعلمانية الثورة الفرنسية (1789) كان كاثوليكيًّا وفرنسا كدولة ذات غالبية
كاثوليكية أيضًا. ومن المعلوم أن الفكر الكاثوليكي في تلك الحقبة التاريخية وما
قبلها – وإلى فترة متأخرة من القرن العشرين – كان رافضًا لفكرة العودة اليهودية
إلى فلسطين أو وجود "الأمة اليهودية" التي انكرت نبوة المسيح ولم تعترف
به، بل وناصبته العداء وقامت بصلبه، وبالتالي ليس لليهود الذين عاقبهم الله على
جريمتهم فشردهم في الأرض العودة إلى فلسطين مرة أخرى إلا كأفراد يمكنهم أن يجدوا
الخلاص الروحي باعتناقهم المسيحية([13])!.
إن رفض الكاثوليكية التفسير الحرفي "للعهـد
القديم"، جعلها غير متعاطفة مع دور اليهود في "رؤيا الخلاص"، وشرط
عودتهم إلى فلسطين لتحقيقها. ([14])
لقد أراد الكتاب اليهود من هذا الترويج
لهذا البيان والثناء على نابليون الادعاء بأن الفكر الكاثوليكي تعاطف معهم انطلاقًا
من فرنسا بعدما ضمنوا ذلك في الفكر البروتستانتي الذي كانت قاعدته بريطانيا. وبذلك
الترويج يصبح الفكر المسيحي الغربي بغالبيته داعمًا للمشروع الصهيوني ومتبنيه بشكل
عام، ويلتقي دينيًّا واستراتيجيًّا معه على أرض فلسطين بشكل خاص. ويحققون في
المقابل من خلال ذلك تجاوز فترة طويلة من العداء التاريخي بين اليهود والمسيحيين
الغربيين، وبالأخص ما كان قبل حركة الإصلاح الديني والتي بدأ معها التعاطف واللقاء
مع اليهود في مشروعهم الاستعماري في فلسطين، والتأسيس لمرحلة تاريخية جديدة من
العلاقة كان لها أثرها البارز في قيامه واستمراره ليومنا هذا!.
-
المرحلة الثانية: الخطوات
التمهيديّة العمليّة لعودة اليهود إلى فلسطين:
وتتضح أبرز معالم هذه المرحلة من خلال النقاط
التالية:
1- الدعوات
العملية لتوطين اليهود في فلسطين:
إن فكرة توطين اليهود التي ظهرت مع حركة
الإصلاح الديني وعقيدة العصر الألفي كشرط لتحقيقها عَمليًّا، دفعت "اللورد
شافتسبري السابع"([15]) أحد
المؤسسين للفكر الصهيوني عام (1838)
إلى المطالبة بتوطين اليهود في فلسطين، مُؤكدًا على أن مقترحه يُمَكّن من حل المشكلة اليهودية في أوروبا، ويخلصها من
الفائض اليهودي الموجود فيها، ويحل "المسألة الشرقية"([16]) في
الوقت نفسه عن طريق إيجاد قاعدة للاستعمار وللحضارة الغربية في قلب العالم
الإسلامي.
ثم قدَّم "مونتيفيوري"([17]) -
في العام نفسه (1838)-
إلى "محمد علي باشا" أثناء حكمه الشام خطة لتوطين اليهود في
فلسطين تضمنت: توفير وضع متميز لليهود، وقدر كبير من الاستقلال الذاتي ومشاريع
زراعية وصناعية تحقق لليهود الاعتماد على الذات. وفي المقابل اقترح
"مونتيفيوري" تأسيس بنوك في المدن الرئيسة في المنطقة، تُقدم التسهيلات
الائتمانية اللازمة لهذه الخطة. إلا أن اعتراض "مجلس القدس الشريف"([18]) دفع
"محمد علي باشا" لرفض هذه المقترحات. وبعد خروج "محمد علي
باشا" من الشام قام "مونتيفيوري" بتأسيس بعض المستوطنات الزراعية
في الجليل ويافا، وساهم عام (1855)
في تمويل شراء بعض الأراضي قرب مدينة حيفا، كما أسس أول حي يهودي خارج أسوار مدينة
القدس القديمة بالإضافة إلى بعض المشاريع الصناعية. وقد وضح
"مونتيفيوري" خطته بخصوص المشروع الصهيوني في مذاكراته عام (1839).([19])
2- تأسيس صندوق اكتشاف فلسطين:
تأسس صندوق اكتشاف فلسطين عام (1865) تحت ستار دراسة التاريخ الطبيعي لفلسطين وآثارها وعادات سكانها
وتقاليدهم دراسة علمية تختلف عن الدراسات التي سبقتها. وبحسب ما قاله عبد
الوهاب المسيري: «إن البحث العلمي قد وُظِّف في خدمة
الأهداف التوراتية»([20]).
لقد رافق ظهور "صندوق اكتشاف فلسطين"
ظهور جمعيات أثرية كان الهدف المعلن للجميع في تلك المرحلة إثبات صحة ما ورد في
كتب اليهود من حوادث تاريخية وأسماء أماكن. لكن مسألة التنقيب عن الآثار واستكشاف
فلسطين كانت في حقيقتها ذات غايات سياسية بالنسبة إلى بريطانيا بخاصة. لأن بريطانيا
كانت تهدف إلى إيجاد ذريعة للقول بدولة يهودية في فلسطين ولإشعال الروح القومية
اليهودية ودفعها في اتجاه الهجرة إلى فلسطين.
لقد أكد نشاط
"صندوق اكتشاف فلسطين" الصلة القوية بين بريطانيا ومشاريع الاستيطان
اليهودي في فلسطين تحت الحماية البريطانية. وكانت تذكر مسألة "عودة
اليهود" إلى فلسطين في اجتماعات الصندوق بشكل دائم. كما شجعت أعمال الصندوق
عملية الاستيطان لأنها قدمت صورة مفصلة عن فلسطين. ([21])
وذكر المسيري في موسوعته:
أنه
«لم
يكن صندوق استكشاف فلسطين الوحيد من نوعه، فبعد خمس سنوات من تأسيسه أسَّس
الأمريكيون الجمعية الأمريكية لاستكشاف فلسطين. وفي العام نفسه، أُسِّست جمعية
الآثار التوراتية في إنجلترا. وأنشأ الألمان جمعيتين: الجمعية الألمانية للدراسات
الشرقية (1897) والجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية (1877). وأسس الفرنسيون
أيضاً مدرسة لدراسة الآثار. وقد كان الحافز وراء الدراسة في كل هذه الجمعيات
توراتيًّا (صهيونيًّا)»([22]).
3- تأسيس "جمعية
الأليانس":
تأسست "جمعية
الأليانس" في باريس بمبادرة من بعض اليهود في فرنسا عام (1860).
وسعت الجمعية منذ البداية، لتكون اتحادًا عالميًّا لليهود بهدف تقديم المساعدة
السياسية والثقافية لليهود أينما كانوا، وتنمية المجتمعات اليهودية المختلفة عن
طريق التعليم والتدريب المهني من خلال الفكرة الداعية إلى وحدة اليهود في كل أنحاء
العالم.
وأوفدت الجمعية أعضاء
لجنتها المركزية إلى فلسطين عام (1868) لدراسة أوضاع اليهود فيها. وبعد تقديم
موفدها تقريرًا قررت الجمعية إقامة مدرسة زراعية في فلسطين لتعليم أبناء اليهود
أصول الزراعة الحديثة، وفي عام (1870)
أقامت مدرسة "ميكفه إسرائيل"([23]) الزراعية على أرض تابعة لقرية "يافا"
بعد إن تمكنت من استئجارها من السلطات العثمانية، فكانت أول مدرسة زراعية من نوعها
لليهود. وأصبحت هذه المدرسة مع بداية الاستيطان الصهيوني لفلسطين مصدر تشجيع
وتدعيم لهذا الاستيطان، ومن العوامل الرئيسة التي صنعت الفلاح اليهودي فيها.([24])
4- تأسيس جماعات أحباء صهيون في روسيا (1882):
أحباء صهيون اسم أطلق
على جمعيات صهيونية قامت في روسيا عام (1881) بعد صدور قوانين تُقيّد حركة الأقلية
اليهودية في هجرتها من روسيا وبولونيا ورومانيا إلى فلسطين. وكان هدف حركة
"أحباء صهيون" محاربة اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها،
والعمل على تهجيرهم إلى فلسطين. وقد اتخذت شعارًا لها: "إلى فلسطين"
ودعت إلى الاستعداد للهجرة لشراء الأراضي فيها، وتنشيط الاستيطان اليهودي هناك.
وكانت حركة أحباء
صهيون همزة الوصل بين ما أطلق عليه بالفكرة الصهيونية في بداياتها الأولى في منتصف
القرن التاسع عشر وبداية الحركة الصهيونية السياسية مع ظهور هرتسل، وانعقاد
المؤتمر الصهيوني الأول.
وقد تمكنت جماعة
"أحباء صهيون" من عقد عدة مؤتمرات طرحت فيها أفكارها ورسمت من خلالها
طريقها إلى استعمار فلسطين. ([25])
-
المرحلة الثالثة: الانتقال إلى التنفيذ العملي
للمشروع الصهيوني:
إن المراحل التي سبقت وجود "هرتسل"
لم تكن مراحل تأسيس منظمة قامت بها جهة واحدة محددة وفق خطط مرسومة، وإنما كانت
عبارة عن خطوات تأسيسية مرتكزة على فكر صهيوني ناشئ في ظل ظروف دينية واستعمارية
تنافسية متحركة تجاه المنطقة العربية الإسلامية. لذلك كانت تلك الخطوات التأسيسية
بطيئة وهادئة تحاول أن تجد لها أرضية ومساندة ودعمًا بين تلك الدول الاستعمارية
المتنافسة والمتصارعة، مستغلة البعد الديني كمحرك في إيجاد قبول لها في العقلية
الغربية التي عاشت معها صراعًا تاريخيًّا مريرًا من الاضطهاد والرفض بسبب هذا
البعد الديني قبل أن يطرأ عليه التغيير الكبير في العقلية المسيحية، وظهور
البروتستانتية المتأثرة بالفكر الديني اليهودي وأدبياته، لاسيما بعد ضمهم كتاب
"العهد القديم" إلى جانب "العهد الجديد" في كتاب واحد تحت
مسمى: "الكتاب المقدس". حيث تطور الاهتمام "بالعهد القديم"
تحت شعار "العودة إلى الكتاب المقدس" حتى أصبح المرجع الأعلى للسلوك
والاعتقاد من قبل الفكر المسيحي في أوروبا البروتستانتية الذي أصبحت فيه أرض
فلسطين أرضًا يهودية، واليهود الذين هم خارجها هم غرباء وسيُعادون إليها عندما
يحين الوقت المناسب([26]).
جاء هرتسل في نهاية
القرن التاسع عشر ليعلن بداية الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشروع الصهيوني
بعد مرحلة طويلة اتسعت فيها قاعدة انتشار الفكر الصهيوني بشكل تدريجي. وقد شكل
وجود هرتسل عنوان بداية لمرحلة جديدة اعتمدت على التخطيط والعمل المنظم لتحقيق
الأهداف الصهيونية. وكان من أبرز معالم هذه المرحلة:
1- التخطيط
ونشر كتاب "الدولة اليهودية" لهرتسل (1896):
لقد نُشرت كتب عدة
قبل صدور كتاب هرتسل تناولت "المشكلة اليهودية"، وكيفية حلها عن طريق
تهجير اليهود إلى فلسطين. فقد نشر القس "وليام هشلر"([27]) الملحق
في السفارة البريطانية في "فيينا" في عام (1894) كتابًا تحت عنوان
"استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء"، طرح فيه قضية عودة
اليهود إلى فلسطين، بناء على قاعدة تطبيق النبوءات الدينية الواردة في
"التاناخ". فكان "هشلر" بذلك أول من طرح عملية تنظيم تهجير
اليهود الروس إلى فلسطين.
كذلك نُشر، من قبل،
في عام 1887
كتيب تحت عنوان "محاولة لحل المسالة اليهودية" لمؤلفه "ألفريد
نوسيج"([28]) أحد
مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتسل، وقد اقترح "نوسيج" إنشاء دولة يهودية
في فلسطين والدول المجاورة. وقد ترك هذا الكتيب أثرًا عميقًا عند المثقفين اليهود
في أوروبا.
كذلك قام
"لورانس أوليفانت"([29]) الصهيوني
غير اليهودي بنشر كتاب "أرض جلعاد" ونادى في هذا الكتيب بضرورة إقامة
مستوطنة يهودية على مساحة مليون ونصف مليون فدان شرقي نهر الأردن لتوطين يهود
روسيا ورومانيا. وكان لورانس من العاملين في "صندوق اكتشاف فلسطين" الذي
كان من أهدافه إثبات يهودية فلسطين وبيان أن لليهود حق فيها.
وبعد
ذلك جاء كتاب هرتسل "الدولة اليهودية" (1896) كثمرة من ثمار الفكر
الصهيوني الذي انتشر في تلك المرحلة، فكان ذا أهمية كبيرة في الفكر الصهيوني
السياسي المعاصر، وأحد أهم الدعائم الرئيسة للفكرة الصهيونية([30])،
وأحد القرائن التي تثبت ارتباط الصهيونية باليهودية. فقد استطاع هرتسل أن يجعل من
الأفكار والمعتقدات اليهودية الاستعمارية "مشروعًا سياسيًّا" قابلًا
للتطبيق على أرض الواقع إذا توافرت المساندة الدولية له. وبدون تطبيق هذا
"المشروع" ستبقى "المشكلة اليهودية" قائمة لأن "الشعب
اليهودي" المنتشر في العالم لا يمكنه الاندماج في الشعوب الأخرى، وهو بهذا
يعني أن المشكلة اليهودية ليست مشكلة دينية سببها يهودية اليهود، وإنما هي مشكلة
سياسية دولية لا بد من طرحها أمام الرأي العالمي، وحلها بالوسائل السياسية([31]).
لقد
أصبح كتاب "هرتسل" الدولة اليهودية، أمام اليهود المعاصرين دليل عمل
للحركة الصهيونية «الذي حدد لهم معالم الطريق، ووضع النقاط على الحروف، وطرح
المشكلات، وقدم لهم الحلول، … آمنت الحركة الصهيونية بمضمونه، واعتبرته دستورًا
لمستقبلها، وسارت على خطى أفكاره حتى تم بناء الدولة اليهودية، بل إن بعض رجالات
الحركة الصهيونية وصفوا الكتاب في منزلة لا تقل عن منزلة التوراة لدى اليهود، كما
وصفوا هرتسل في منزلة لا تقل عن منزلة موسى (عليه السلام)»([32]).
1-
تأسيس
المنظمة الصهيونية العالمية:
لقد اعتمد زعماء
الحركة الصهيونية في طرح مشروعهم الاستعماري في فلسطين على اتباع استراتيجية تنظيم
الحركة والعمل وتنسيق الجهود من خلال تأسيس مؤسسات تعمل لخدمة المشروع الصهيوني
وتحقيق أهدافه. لذلك بعدما طرحت فكرة المشروع في مؤتمر بال في سويسرا عام (1897)،
وأثناء انعقاد المؤتمر تم تأسيس "المنظمة الصهيونية العالمية"([33]).
2- تأسيس المنظمات العسكرية:
لم تقتصر
مرحلة تأسيس المشروع الصهيوني على تكثيف النشاط السياسي، وتأسيس المنظمات السياسية
والثقافية والاقتصادية، وإنما شمل التركيز على الجانب العسكري، على اعتبار أن هذا
الجانب يشكل الأداة العملية لتنفيذ المشروع والدفاع عنه. إذ لا يمكن لسكان فلسطين
العرب التخلي عن أرضهم وتسليمها لليهود عن طيب خاطر مقابل الادعاء بمزاعم دينية،
وتنفيذًا لمشاريع استعمارية في المنطقة من خلالها. وبخاصة أن الأرض التي حاول بعض
القادة الصهيونيين تصويرها على أنها أرض خالية لتسهيل هجرة اليهود إليها كانت
مسكونة من قبل أهلها منذ مئات السنين، ولكن هؤلاء السكان وفق التصور الديني
اليهودي هم مغتصبون لتلك الأرض، وأنهم أناس مُتخلفون، ولا يمتون بصلة إلى الآدمية
التي يتفرد بها اليهود، لذا لا يمكن التعامل معهم إلا عن طريق الحديد والنار
لاستئصالهم منها وبناء "الدولة اليهودية".
ومن هنا جاء
الاهتمام بالجانب العسكري وإعطائه الأولوية والأهمية في عملية بناء المشروع
الصهيوني. فقد تم تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية "بار جيورا" في
فلسطين (1907)،
وتأسيس منظمة "الحارس" العسكرية لحراسة
المستوطنات (1909)، وأسس
"فلاديمير جابوتنسكي" فرقة "البغالة" لمساعدة البريطانيين في
غزو فلسطين وتكوين نواة قوة عسكرية صهيونية (1915)،
وتأسيس "المنظمة العسكرية الصهيونية" في
القدس لتأمين الاستيطان (1919)،
وتأسيس منظمة "الليحي" الإرهابية، وتأسيس كتائب "الجدناع" لحراسة المستوطنات وتدريب
الشباب الصهيوني عسكريًّا (1938)، وتأسيس القوات الضاربة
"البالماح" في صفوف الهاجانا(1941) التي كانت نواة تشكيل
"جيش الدفاع الإسرائيلي"، وتشكيل
"اللواء اليهودي" لمساندة القوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية
(1944).([34])
3-
تأسيس
الأحزاب السياسية والدينية:
اتبعت الصهيونية
استراتيجية العمل المنظم التي يمكن أن تجعل غالبية اليهود ضمن المشروع الصهيوني
فكريًّا ودينيًّا وعسكريًّا وسياسيًّا، وذلك من خلال التركيز على إنشاء الأحزاب
السياسية والدينية في فلسطين. فقد شهدت المرحلة التأسيسية لاسيما بعد انعقاد
المؤتمر الصهيوني الأول (1897)
ولادة نواة معظم الأحزاب والحركات السياسية والدينية اليهودية التي تركز نشاطها في
تلك الفترة على الاهتمام بالجانب السياسي ومن ثم بالجانب العسكري. ويمكن القول: إن
معظم اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين كانوا جزءًا من تلك الحركات والأحزاب التي
تأسست في تلك الفترة والتي كان لها الدور الفاعل في بناء المشروع الصهيوني.
ولإيضاح مدى الاهتمام الصهيوني بتأسيس الأحزاب والحركات اليهودية في مرحلة مبكرة
من طرح المشروع الصهيوني نقف عندها بشكل مختصر([35]):
فقد تم تأسيس حزب "مزراحي"
(اختصار لعبارة مركز روحي) الديني عام (1902) وذلك بإيعاز من "هرتسل" وبتمويل
من ماله الخاص تحت شعار "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، وفقًا لتوراة
إسرائيل". وفي عام (1905)
تم تأسيس الحزب العمالي "هابوعيل تسعير" في فلسطين. ونتيجة لتصاعد تأسيس
الأحزاب العمالية وتصاعد نشاطها تأسست "حركة أجودات إسرائيل" عام (1912)
كتنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا (كمجموعة
متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليهودية، كما تصدت
الحركة للحركات العلمانية الأخرى كافة. وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد
إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية. كما أُنشئ
حزب "أحدوت هاعافودا" (العمل الموحد) سنة (1919) في فلسطين كحزب
صهيوني عمالي اشتراكي ضم عمالًا زراعيين وسكان مدن وجنودًا خدموا في الجيش
البريطاني. وفي عام (1930)
تأسس حزب "الماباي" (اختصارًا لعبارة مفليجيت بو علي إيرتس
يسرائيل" أي "حزب عمال أرض إسرائيل". وكان من أشهر قادته "بن
جوريون" و"ليفي أشكول" و"جولدا مائير" و"موشي
دايان" و"شمعون بيريس" و"إسحاق رابين". وقد كان لتلك
الشخصيات الدور الأساسي في بناء المشروع الصهيوني. كما تأسس حزب "حيروت"
(حركة الحرية) في عام (1948)،
وكان من الأحزاب الرئيسة في "إسرائيل"، ومن أشدها تمسكًا بالمبادئ
الصهيونية وأيديولوجيتها.
فتشكيل الأحزاب الكثيرة داخل المجتمع اليهودي
وتحالفها في كتل كبيرة: "كحزب الليكود" و"حزب العمل" كان له
دور بارز في مأسسة هذا المجتمع الذي تشكل حديثًا من جنسيات مختلفة جاءت من جميع
أصقاع الأرض، فوحدت أهدافه وأعطته هامشًا واسعًا من الحرية والاختلاف في الوسائل
من أجل التنافس في عملية بناء المشروع الصهيوني، وكان ذلك أحد أهم عوامل النجاح في
قيامه إلى جانب العامل الأول وهو القوة العسكرية.
4-
افتتاح
الجامعة العبرية في القدس 1925:
إن حركة المشروع الصهيوني كانت تسير
بشكل منظم لبناء دولة، ولذلك كان هناك اهتمام وتركيز على تأسيس الجوانب المهمة
والأساسية التي تحتاجها، ومن ذلك كان تأسيس "الجامعة العبرية" التي تعد
أول جامعة يهودية تقام على أرض فلسطين. ففي (4) آب عام (1918)
قام الجنرال "أللنبي"([36]) بوضع
حجر الأساس للجامعة العبرية في "جبل الزيتون" في
القدس وسط احتفال الآلاف من اليهود، وتم افتتاحها عام (1925) بحضور عدد من
الشخصيات الصهيونية البارزة وعدد من ضباط الجيش البريطاني ورجال الحكومة
البريطانية([37]).
وتضم "الجامعة العبرية" مكتبة ضخمة تعرف باسم "مكتبة الجامعة
العبرية" التي تحوي اليوم وفق المصادر الإسرائيلية على ما يزيد عن خمسة مليون
كتاب!. ([38])
5-
شهادة الميلاد "القانونية"
من الأمم المتحدة:
حرص قادة المشروع الصهيوني
بعدما شعروا أنهم قد أتموا المرحلة التأسيسية من المشروع الصهيوني من النواحي
العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمة الحصول على شهادة ميلاد
قانونية من هيئة الأمم المتحدة التي أصدرت في (29) تشرين
الثاني عام (1947) قرارها بتقسيم فلسطين، وإقامة دولتين فيها واحدة
يهودية والأخرى عربية.
وكان
قرار الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة في (29/11/1947) (رقم 181/2) قد أعطى نحو (56%) من فلسطين لتكون
"دولة يهودية" في الوقت الذي لم تكن فيه أملاك اليهود في فلسطين حتى
صدور قرار التقسيم تتجاوز (6.5%) من مساحة فلسطين([39]). ومع ذلك جاء قرار
التقسيم ليشكل الخطوة الثانية – بعد وعد بلفور الذي تبنته عصبة الأمم – ليضفي على
اغتصاب اليهود لفلسطين الشرعية الدولية المطلوبة في تلك المرحلة، ومن ثم جاء إعلان
قيام "دولة إسرائيل" في (15/5/1948) ليعلن
نهاية مرحلة التأسيس العملية وبداية متطلبات المرحلة الجديدة من حيث التثبيت
والوسع والهيمنة في المنطقة بدء من جزء من فلسطين.
من خلال ما سبق يمكن القول:
إن المشروع الصهيوني بدأ كفكرة مع بدايات القرن السادس عشر مع تصاعد حركة الإصلاح
الديني في أوروبا، ثم تطورت الفكرة إلى دعوات سياسية دينية، ثم انتقلت إلى مرحلة
عملية منظمة بدأت على يد هرتسل بانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام (1897) وانتهت
بإعلان قيام "دولة إسرائيل" عام (1948)، لتبدأ مرحلة جديدة لها تفصيلاتها
التي ما زالت مستمرة إلى اليوم.
لذلك من دون دراسة المراحل التي مر بها المشروع
الصهيوني، والطرق والوسائل والأدوات التي اعتمد عليها اليهود من الناحيتين
المعنوية لاسيما الدين منها والمادية وبالخصوص العسكرية منها، وفهم العلاقة
الترابطية بين الفكر الديني اليهودي والفكر المسيحي الغربي اليوم لا يمكن مواجهته
بشكل فعَّال وصحيح.
([5]) قانون التولية: «هو مرسوم أصدره البرلمان
الإنجليزي عام 1701م، بعد وفاة الأمير ويليام أخر أبناء الملكة آن على قيد الحياة
عام 1700، لتسوية الخلاف حول ولاية العهد التاج والعرش الإنجليزي والأيرلندي لتكون
من نصيب من أقرب البروتستانت صوفيا أميرة هانوفر وحفيدة جيمس الأول ملك إنجلترا من
أبنته إليزابيث ملكة بوهيميا وناخبة بالاتينات ومن بعدها ورثتها البروتستانت فقط،
حيث منع المرسوم تولي الكاثوليك عرش بريطانيا بحيث تم استبعاد الملك جيمس وذريته
الكاثوليك الذين يعتبروا أخوة الغير أشقاء لـ الملكة آن، ومع وفاتها قبل الملكة آن
بأسبوعين انقل الحق إلى أبنه الأكبر جورج الأول والذي أساس أسرة هانوفر العريقة».
(انظر: الويكيبيديا: قانون التولية، https://goo.gl/UmRaH7 ).
([6]) أوليفر كرومويل: (1599- 1658) رئيس
الجمهورية التي أقامها في إنجلترا عام (1654) ينحدر من عائلة يهودية مُتنصرة، أصبح
عضوًا في البرلمان ثم ارتقى سريعًا إلى مرتبة الزعامة لكفاءته الحربية، وعبقريته،
عمل على الإطاحة بالملك البريطاني "شارلس الأول"، بعد ذلك حل "كرومويل"
البرلمان ومن ثم في العام التالي ألغاه، وحكم البلاد بالاشتراك مع كبار قواد الجيش
ورفض أن يتوج ملكًا وعرف بالتسامح الديني تجاه اليهود والبروتستانت. (انظر: أحمد
الزغيبي: العنصرية اليهودية، مج1، ط1، العبيكان، الرياض، 1998، ص212.)
([9]) نابليون
(1769- 1821): إمبراطور فرنسا في الفترة بين 1804 ـ 1814، وهو يُعَدُّ من
أهم القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية. وُلد نابليون في جزيرة
كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حروب الثورة الفرنسية، وأحرز نجاحاً
كبيراً في حملته على إيطاليا (1796 ـ 1797)، ولكن حملته على مصر (1798 ـ 1799)
أخفقت تماماً. وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار، فقام بانقلاب
عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا «الثورية». ثم أدخل إصلاحات على النظام
التعليمي وفي مجال القانون ونظَّم العلاقة مع الكنيسة (1801)، ثم أصبح إمبراطوراً
عام 1804، وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي. وقد امتدت رقعة
الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل أوروبا تقريبًا. وساهم في تحديث أوروبا
ومؤسساتها السياسية والإدارية من خلال حروبه. ولكن شوكة نابليون انكسرت حينما حاول
غزو روسيا، وانتهى الأمر بأن هُزم تمامًا ونُفي إلى جزيرة إلبا (1814) ثم إلى سانت
هيلينا (1815). (انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهودية واليهودية والصهيونية،
مج3، ط1، دار الشروق، مصر، 1999، ص 56).
([10]) نص البيان الذي نسب إلى نابليون: «من
نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في إفريقيا
وآسيا إلى ورثة منطقة فلسطين الشرعيين..: أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد،
الذي لم تستطع قوى الاحتلال والطغيان أن تسلبهم اسمهم، ووجودهم القومي، وإن كانت
قد سلبته أرض الأجداد فقط.. إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين وإن لم تكن
لهم مقدرة الأنبياء مثل إشعياء ويوئيل قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع
من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم: أدركوا أن عتقاء الله سيعودون لصهيون وهم يغنون،
وسيولد الابتهاج بتملكهم لإرثهم دون إزعاج فرحًا دائمًا في نفوسهم (إشعياء 35:10).
انهضوا
إذن بسرور أيها المبعدون. إن حربَا لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، تخوضها أمة دفاعًا
عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها أرضها التي توارثوها عن الأجداد غنيمة ينبغي أن
تقسم بينهم حسب أهوائهم. إن أمامكم حربا مهولة يخوضها شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه
أن أرضه التي ورثها عن الأجداد غنيمة تقسم بينهم. وبجرة قلم من مجلس الوزراء تقوم
للثأر وللعار الذي لحق بها وبالأمم الأخرى البعيدة. ولقد نسي ذك العار تحت قيد
العبودية والخزي الذي أصابكم منذ ألفي عام. ولئن كان الوقت والظروف غير ملائمة
للتصريح بمطالبكم أو التعبير عنها، بل وإرغامكم على التخلي عنها، فإن فرنسا تقدم
لكم إرث إسرائيل في هذا الوقت بالذات، وعلى عكس جميع التوقعات.
إن
الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به والذي يقوده العدل ويواكبه النصر جعل القدس
مقرًّا لقيادتي، وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تعد ترهب مدينة
داود.
يا ورثة فلسطين الشرعيين: إن الأمة التي لا
تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادهم لجميع الشعوب (يوئيل:
6:4) تدعوكم لا للاستيلاء على إرثكم بل لإخذ ما تم فتحه والاحتفاظ به بضمانها
وتأييدها ضد كل الدخلاء.
انهضوا واظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد
شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال الذين كان تحالفهم الأخوي شرفًا لإسبرطة وروما، وإن
معاملة العبيد التي دامت ألفى عام لم تفلح في إخمادها.
سارعوا!
إن هذه هي اللحظة المناسبة – التي قد لا تتكرر لآلاف السنين – للمطالبة باستعادة
حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين وهي
وجودكم السياسي كأمة بين الأمم، وحقكم الطبيعي المطلق في عبادة يهوه، طبقًا
لعقيدتكم، علنا وإلى الأبد (يوئيل: 4:20)». (انظر ريجينا الشريف: المرجع السابق، ص
105- 106).
([11]) وعد نابليون لليهود
خرافة ردًّا على مأمون كيوان: صقر أبو فخر، العربي الجديد، 13 /11/2014، موقع
الكتروني، https://goo.gl/BSZcWe
([15]) اللورد شافتسبري السابع: (1808-1885) هو
"أنتوني أشلي كوبر" واحد من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع
عشر. كان زعيم حزب "الإنجيليين. لذلك كان اليهود أحد موضوعاته الأساسية كما
كانوا محط اهتمامه الشديد. وقدم "شافتسبري" وثيقة إلى بالمرستون"
رئيس الوزراء البريطاني في الخامس والعشرين من سبتمبر عام (1840) لاسترجاع اليهود
وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة بلاد الرافدين حتى البحر
المتوسط. (أحمد الزغيبي: العنصرية اليهودية، مج/1، ص229-230).
([16]) المسألة الشرقية: هي مسألة وجود
العثمانيين المسلمين في أوروبا وطردهم منها واستعادة القسطنطينية من العثمانيين
بعد سقوطها في (1453) وتهديد مصالح الدول الأوروبية في هذه المنطقة. كما يدل
المصطلح على تصفية أملاك رجل أوروبا المريض في البلقان من طرف الدول الأوروبية.
(انظر: عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية، مج3، ص57).
([17]) موسى مونتيفيوري: (1784- 1885) ثري ومالي
بريطاني، وزعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا، ومن كبار المدافعين عن الحقوق
المدنية لليهود في إنجلترا. وقد ارتبط بعائلة "روتشيلد" المالية الثرية
من خلال المصاهرة، الأمر الذي ساعده من الناحية المالية. (أفرايم ومناحم تلمي: معجم
المصطلحات الصهيونية، ترجمة أحمد بركات العجرمي، ط1، دار الجليل للنشر، الأردن،
1988. ص 264).
([19]) ومما قاله "مونتيفيوري" حول خطته:
«من كل المعلومات التي استطعت جمعها اتضح لي أن الأرض المجاورة تبدو أنها صالحة
على الخصوص للاستغلال الزراعي. فهنا أحراش من أشجار الزيتون يغلب على ظني أنها
تعود إلى خمسمائة عام وحقول كرم ومراع شاسعة وعدد كبير من الآبار. كما توجد أشجار
تين وحقول قمح وشعير غنية، فهي في الحقيقة أرض يمكن أن تنتج أي شيء بكثرة في مقابل
قليل من المهارة والعمل. إنني واثق من أنه لو نجح المشروع الذي أفكر فيه فإنه كفيل
بتحقيق السعادة والرخاء للأرض المقدسة، وسأبدأ بأن أطلب من "محمد علي"
منحي أرضًا لمدة خمسين عامًا ومائة أو مائتي قرية، وسأعطيه ربحًا يتراوح بين عشرة
وعشرين في المائة على أن يكون دفع المبلغ بأجمعه سنويًّا في الإسكندرية، بشرط أن
تعفى الأرض والقرى التي ستمنح طول المدة من أية ضريبة يفرضها الباشا ـ أي محمد علي
ـ أو حاكم المناطق التي ستمنح فيها الأرض، وبشرط أن أحصل على حرية التصرف في
المحصول في أية جهة من جهات العالم، فإذا حصلت على المنحة فإنني سأستعين بالله بعد
عودتي من إنجلترا وأُنشئ شركة تتولى زراعة الأرض وتشجع أبناء ديننا في أوربا على
العودة إلى فلسطين. إن كثيرين من اليهود يهاجرون إلى ويلز الجنوبية الجديدة وكندا،
ولكنهم يستطيعون في الأرض المقدسة أن يجدوا فرص النجاح المؤكد. هنا سيجدون الآبار
التي تم حفرها وأشجار الزيتون والكروم التي تم زرعها والأرض الخصبة التي لا يعوزها
إلا القليل من السماد. وإنني لآمل أن أُوفق تدريجيًّا إلى إعادة آلاف من أبناء
ديننا إلى أرض إسرائيل. كما أنني واثق من أنهم سيكونون سعداء عندما يتبينون أن
ديننا المقدس قد رُعي بطريقة يستحيل تحقيقها في أوربا». (انظر: علي محمد علي: ملف
وثائق ووراق القضية الفلسطينية، مج1، ط1، مركز دراسات الشرق الأوسط، مصر، لا. ت. ص
29 ـ 30.)
([23]) ميكفه إسرائيل: هي قرية شبابية ومدرسة
داخلية في وسط "فلسطين، أنشئت عام 1870 على قطعة أرض جنوب شرق يافا مؤجرة من
السلطان العثماني، فكانت أول مدرسة زراعية يهودية فيما سمي بدولة "إسرائيل.
وكان الهدف أن تكون مؤسسة تعليمية حيث يمكن لليهود الصغار تعلم الزراعة والخروج
لتأسيس القرى والمستوطنات. (الويكيبيديا: ميكفه إسرائيل، https://goo.gl/xYppBe )
([27]) وليام هشلر: (1845- 1931) قسيس مسيحي،
ولد في جنوب أفريقيا من أبوين ألمانيين، وعمل قسيسًا بريطانيًّا. وقد تنبأ في
كتابه "استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء"، الذي نشر عام 1884
بعودة اليهود إلى فلسطين وذلك بإجرائه حسابات خاصة، وعندما عين قسيسًا ملحقًا
بالسفارة البريطانية في فيينا تعرف على هرتسل وأصبح صديقًا حميمًا له. وقد حضر
المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل في سويسرا. (انظر أحمد الزغيبي: العنصرية
اليهودية، ج3/ص28-29).
([28]) ألفريد نوسيج: (1864-1943) أحد مؤسسي
الحركة الصهيونية مع هرتسل. وقد نشر في عام (1887) كتابًا بعنوان: "محاولة
لحل المسألة اليهودية"، اقترح فيه إنشاء دولة يهودية في فلسطين والدول
المجاورة. شارك "نوسيج" في المؤتمرات الصهيونية، وأسس عام (1908) منظمة
استيطانية تسمى "إيكو" للتعجيل بنقل اليهود. وقد دفعه تحمسه لنقل اليهود
إلى فلسطين إلى التعاون مع النازيين، فعمل كمخبر للسلطات النازية إبان الحرب
العالمية الثانية لتسهيل نقل اليهود إلى فلسطين. فاكتشف أمر تعاونه مع النازية
فحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص ونفذ الحكم في 22 شباط عام 1943. (الويكيبيديا:
ألفريد نوسيج، https://goo.gl/BKtMTb )
([29]) لورانس أوليفانت: (1829-1888) دبلوماسي
بريطاني وعضو في البرلمان الإنجليزي، دعا إلى توطين اليهود في فلسطين والضفة
الشرقية لنهر الأردن، من خلال شركة استيطانية برعاية بريطانية، واتجه إلى فلسطين
بالفعل ليبحث عن المكان المناسب للوطن المقترح، وبالفعل نجح في تهجير سبعين يهوديًّا
من أصحاب الحرف إلى فلسطين، وكتب له بعض أعضاء أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق
وحده هو الذي أرسله لقيادة اليهود، وأسموه "المخلص" أو "كورش الثاني".
(انظر: المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج6، ص166).
([36]) الجنرال أللنبي: هو "أدموند هنري أللنبي"
(1861-1936)، قائد عسكري بريطاني اشترك في لحرب العالمية الأولى، وقاد الحملة
البريطانية من مصر عام (1917) فغزا فلسطين واستولى على القدس وسوريا، وهزم الأتراك
بمساعدة "جيش الثورة العربية الذي كونه ضابط المخابرات البريطاني
"لورانس". وعندما دخل اللنبي" القدس قال قولته المشهورة:"
اليوم انتهت الحروب الصليبية". (انظر: الويكيبيديا، إدموند
أللنبي، https://goo.gl/RuVnm .)
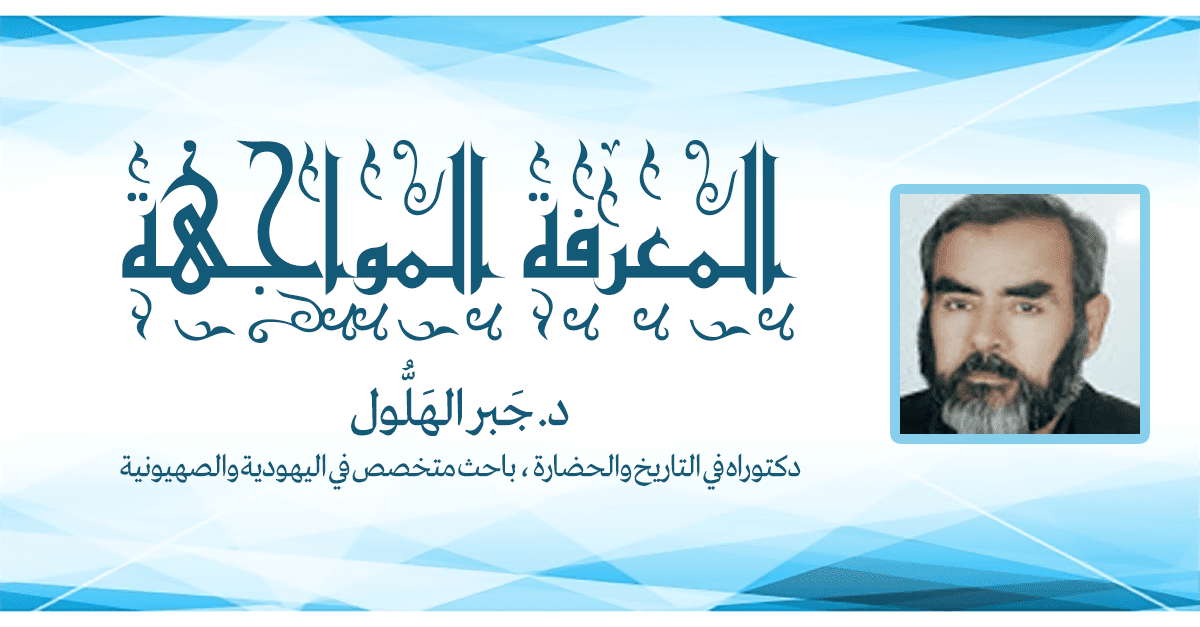
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات