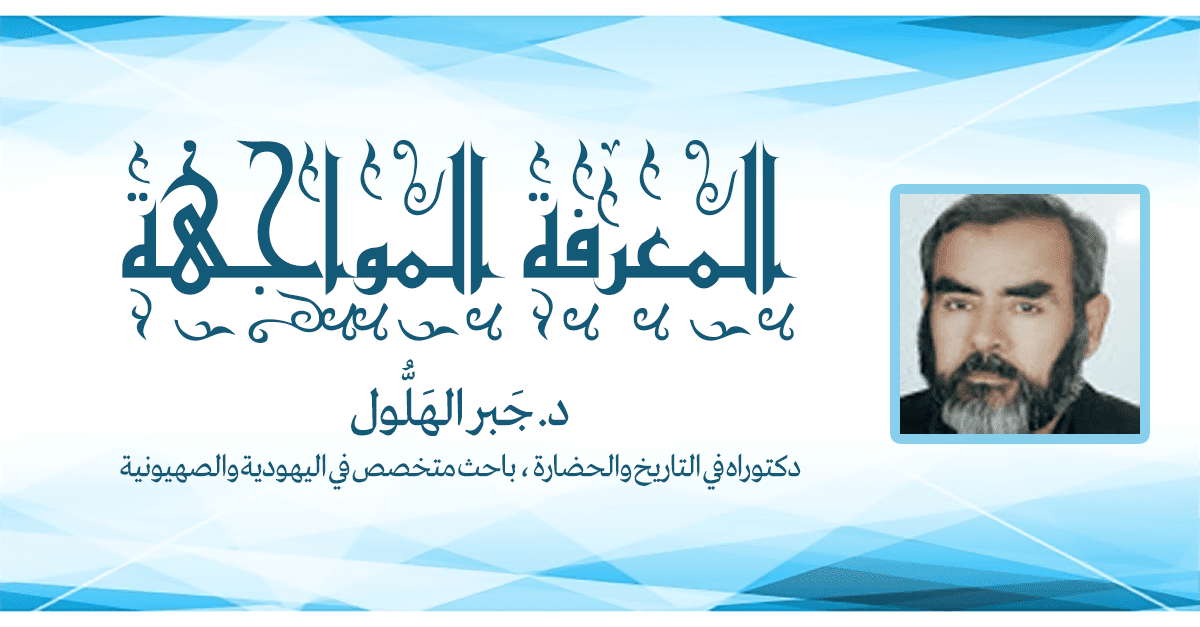منهجية إسرائيل
في التعاطي مع المنظمات الدولية
الدكتور جبر الهلول
الدكتور جبر الهلول
إن
مطالبة إسرائيل في الفترة الأخير بمقعد في المنظمة الدولية يبدو طريفًا إذا ما نظر
إلى عدد القرارات التي التزمت بتنفيذها منذ لحظة قبولها فيها وإلى غاية الآن. إذ
من المعلوم أن "إسرائيل" وجدت بين دول العالم بقرار دولي! لكنها منذ
الساعات الأولى لتأسيسها رفضت تنفيذ القرارات الدولية التي لا ترضيها ولا توافق
مشروعها الصهيوني. فقد اتخذ مجلس الأمن الدولي (17) قرارًا في الفترة ما بين
1967-1986 بشأن الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ولم تنفذ "إسرائيل"
أي قرار منه.
وهنا
يطرح سؤال: ما هو مبرر "إسرائيل" لرفض كل القرارات الدولية والانصياع
إلى مبادئ هيئة الأمم المتحدة؟ أي ما هي العلاقة بين الصهيونية والقانون الدولي؟
وللجواب
على هذا السؤال لا بد من معرفة الثوابت التي تقوم عليها الصهيونية، لكي نحدد أسس
هذه العلاقة.
وبالعودة
إلى العقيدة الصهيونية، نراها تقوم على « ثوابت ثلاثة:
1.
إن اليهود هم
شعب الله المختار.
2.
إن الله وعد
اليهود وملكهم "أرض الميعاد" من النيل إلى الفرات.
3.
إن ظهور المسيح
[المنتظر] مرتبط بقيام صهيون، وبتجميع اليهود فيها حتى يظهر المسيح فيها.
فمن
خلال الثابت الأول في العقيدة الصهيونية تضع "إسرائيل" نفسها في مكانة
أعلى من كل القوانين الإنسانية، وتتجاهل بالأخص كل قرارات أو إدانات الأمم
المتحدة، باعتبارها صادرة عن "الغوييم" – الحيوانات بصورة بشرية –
وهم "الشعب المختار" ولا يمكن
أن يخضع "الشعب المختار" لقرارات "الغوييم". للاختلاف في
الجنس والمكانة!! وإنما يخضع فقط لشريعة إلهه التي منها تخرج القوانين التي «تجبّ
قوانين كل الدول الأخرى»([1])
بما فيها قرارات المنظمات الدولية.
أما
بالنسبة للثابت الثاني: حيث أن الله وعد اليهود وملّكهم "أرض الميعاد"
من النيل إلى الفرات" يعني أنه لا يجوز مطالبة اليهود بالانسحاب من "أرض
الميعاد" لأن الله وعد "شعبه الخاص" – بني إسرائيل – بأرض فلسطين
ميراثًا أبديًا.
«ومن
الواضح أن ترسيخ مثل هذه المفاهيم يلعب دورًا بالغ الأهمية، بل يكاد يكون أساسيًا،
في دعم التصلب والرفض الإسرائيليين. فإذا كانت أرض فلسطين "ملكًا"
لليهود وعلاقتهم بها "تاريخية" و"أزلية" و"ربانية"
مستمدة من (الله) والتوراة، فلا يجوز مطالبتهم بالانسحاب من أجزاء منها. وكل مطلب
من هذا القبيل من قبل الفلسطينيين العرب – أصحاب أرض فلسطين-، أو غيرهم هو،
باعتبارهم طبعًا، عمل "غير أخلاقي" لأن "الأمر التوراتي" الذي
يلزم الشعب اليهودي بالاستيطان في طول أرض "إسرائيل" وعرضها، لا يخضع
لأي سلطة دنيوية»([2]).
وقد
عبر عن هذا الثابت في العقيدة الصهيونية العديد من قادة "إسرائيل":
فقالت "جولدا مائير": «إن وجود هذه الدولة هو تجسيد للوعد الإلهي. ومن
السخف أن يطالب أحد بإثبات شرعيتها بغير ذلك».
ويكرر
"مناحيم بيغن" هذه الفكرة فيقول: «لقد وعدنا بهذه الأرض ولنا الحق فيها».
أما موشي ديان فيقول: «إذا كنا نمتلك التوراة، ونعتبر أنفسنا شعب التوراة، فمن
الواجب علينا شرعًا أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة، أراضي القضاة
والآباء. أراضي أورشليم وحبرون وأريحا، والأراضي الأخرى».
ومن ثم جاءت الممارسات اليهودية متطابقة مع هذا الثابت الذي
يرتكز على فكرة "أرض الميعاد" فاستولوا على فلسطين وطردوا أهلها وأخذوا
من منهج يشوع خليفة موسى (عليه السلام) عندما استولى على "أريحا"
و"عاي" منهجًا عمليًا يطبقونه على أرض الواقع من أجل
"استعادة" "أرض الميعاد" كما يقول بيغن: «سوف تعود أرض
إسرائيل الكبرى إلى شعب إسرائيل، كاملة والى الأبد»([3]).
-
أما الثابت الثالث: إن ظهور المسيح مرتبط بقيام صهيون وبتجميع اليهود فيه
حتى يظهر المسيح المنتظر، وقد قامت "دولة صهيون" في 15/5/1948 وجاء في
بيان إعلان استقلال إسرائيل: «إن إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي. هنا تكونت هويته
الروحية والدينية والقومية. وهنا أقام دولته للمرة الأولى. وخلق قيمًا حضارية ذات
مغزى قومي وإنساني. وفيها أعطى للعالم الكتاب المقدس»([4]). ويحتوي هذا الكتاب الشريعة التي يجب أن ينقاد إليها
العالم، كما جاء في سفر إشعيا: «يكون في الأيام الآتية أن جبل بيت الرب يثبت فوق
التلال إليه تتوافد جميع الأمم، ويسير شعوب كثيرون يقولون: لنصعد إلى جبل الرب إلى
بيت إله يعقوب فيعلمنا أن نسلك طرقه. فمن صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة
الرب. الرب يحكم بين الأمم ويقضي لشعوب كثيرين، فيصنعون سيوفهم سككًا ورماحهم
مناجل. فلا ترفع أمة على أمة سيفًا ولا يتعلمون الحرب من بعد»([5]). وهذا النص هو القاعدة الأساسية "لمفهوم السلام"
الذي يحلم اليهود بالوصول إليه. ويجب على اليهود الحاليين أن يمهدوا لذلك، لكن
المهمة الأساسية والعالمية تقع على عاتق "المسيح المنتظر"، التي
"لن تقتصر على إنقاذ "الشعب" من أعدائه وتحقيق "خلاصه"
بل ستشمل، وبشكل أساسي، نظرًا لأنها منطوية على إقامة ملك "يهوه" على
الأرض، أي الكرة الأرضية – فرض القانون من صهيون على كل الأمم، وفرض السلام الإسرائيلي
على كل أركان المعمورة، وإذ ذاك يبدأ العصر الذهبي بحق، وينام الحمل مع الأسد،
ويرقد الإنسان مع الحية، ويتحقق غرض يهوه من خلق العالم»([6]).
وهكذا نجد أن "إسرائيل" وصفت نفسها منذ البداية
ومن خلال هذه الثوابت الدينية فوق القوانين الدولية كافة([7]), لأن هذه الثوابت تعني أمرًا واحدًا، هو أن القانون الذي
يلتزم به اليهود هو قانون إلهي. وحينما يتعارض القانون الإلهي مع القانون الدولي،
فإن قانون إلههم هو الذي يجب أن ينفذ لأنه يعكس إرادة الله ومشيئته. هذه الإرادة
محددة بتمليك اليهود أرض فلسطين، وبحقهم غير المشروط في الاستيطان فيها، وبتعامل
شعوب العالم معهم على أساس أنهم "أمة الله" و"شعبه المختار"
الذي يسمو فوق كل قوانين الأمم وأنظمتها، وإن كل عمل يقومون به على أرض الواقع هو
تعبير عن إرادة الإله لا بد من تقبله واحترامه من قبل الآخرين([8]).
ومن هنا فإن "إسرائيل" في نظر ذاتها، وفي نظر
الغرب لاسيما المسيحية "البروتستانتية" هي مالكة القرار وصانعته، فهي
فوق العقاب، وفوق الإدانة، إنها فوق القانون الدولي، لأنها فوق حسابات البشر([9]).
وريثما تتحقق "رؤيا الخلاص" لليهود، فإنه يجب أن
تقوم المنظمة الدولية مؤقتًا، ومرحليًا، «من نيويورك العاصمة الحقيقية للحركة
المتجهة بنشاط وذكاء وتصميم إلى إقامة ذلك الملك "اليهيوي" [نسبة إلى
يهوه] على كل الأرض، بمهمة "فرض القانون"، و"إنصاف الشعوب"
وصون السلم، وجعل الشعوب تلقي أسلحتها وتنصرف إلى الأنشطة السلمية التي يفضل أن
تكون زراعية، حتى لا ترفع أمة سيفًا ولا تتعلم الحرب تاركة بقاءها أمانة في عنق
"القانون" الذي لن يلبث أن يخرج رأسًا، وبغير وساطة، من صهيون باعتباره
كلمة الرب»([10]).
فثوابت العقيدة الصهيونية هي الأسس التي تجعل
"إسرائيل" ترفض وتنقض جميع القرارات والمبادئ الدولية، ولكن بالمقابل
وجدنا أن المنظمات الدولية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق إصدار القرارات
والتوصيات في "إنشاء الكيان الصهيوني" وعملت على تقويته وتعزيز وجوده في
الشرق الأوسط. وهذا يدفعنا للسؤال عن الدور الذي قام به الصهيونيون في إنشاء هذه
المنظمات؟!
"فعصبة
الأمم" التي أنشأها الحلفاء، بعد (الحرب العالمية الأولى) عام 1920م، بهدف
(ضمان السلم العالمي) – فيما يدعون – هي هدف صهيوني ينطلق من "رؤيا
الخلاص" السالفة الذكر، وقد قال الزعيم الصهيوني "ناحوم سوكولوف" في المؤتمر اليهودي الذي عقد بعد قيام
"عصبة الأمم" في "كارلسباد – تشيكوسلوفاكيا" بتاريخ 27 من آب
1922، ونشرته جريدة "نيويورك تايمز" في اليوم التالي: «إن "عصبة
الأم"م فكرة يهودية، لقد خلقناها [أحدثناها] بعد كفاح دام 25 سنة ستكون القدس
يومًا ما عاصمة للسلم العالمي. وإن ما حققناه نحن اليهود بعد كفاح 25 سنة يرجع
الفضل فيه إلى زعيمنا الخالد تيودور هرتسل»([11]).
ويؤكد صحة قول "سوكولوف" أن أول عمل قامت به
"عصبة الأمم" بعد قيامها هو توجيه رسالة رسمية إلى الصهيوني "حاييم
وايزمن" تؤكد فيها أن حماية حقوق اليهود ستكون من أهم واجبات عصبة الأمم.
وبالفعل قامت "عصبة الأمم" بذلك على أكمل وجه إذ فرضت الانتداب
البريطاني على فلسطين من أجل تحقيق هدف سياسي واحد هو تنفيذ وعد بلفور وتهويد
فلسطين([12]).
كما أن "هيئة الأمم المتحدة" التي أعقبت
"عصبة الأمم"، تمكن اليهود من احتوائها منذ إنشائها – إلى أيامنا هذه –
وقد أظهرت الإحصائيات التي أعقبت تأسيسها أنها تضم نسبة 60% من موظفيها يهود،[13]). وعن هذا الاحتواء قال بن غوريون عام 1948: «إن هدف الأمم
المتحدة هو مثل أعلى يهودي»([14]). وقال أحد الصهاينة أيضًا: «هيئة الأمم المتحدة فكرة
صهيونية، إنها الحكومة العليا التي ورد ذكرها عدة مرات في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون»([15]).
قد يقول قائل إن هذه الأقوال تحتمل التصديق والتكذيب وبخاصة
أن اليهود يحاولون أن يوهموا أن جميع مراكز القرار ومواقع القوة تحت تأثيرهم وتعمل
لخدمتهم وأن سبب نشوئها وقوتها يعود إليهم!! ولكننا نقول: صحيح أن هذه الأقوال لا
تخرج عن المزاعم الصهيونية التي تعبر عن "الشخصية اليهودية العجائبية"
التي لا يقهرها شيء!! إلا أن ما قامت به "عصبة الأمم" ومن ثم "هيئة
الأمم المتحدة" منذ ظهور فكرة تأسيس "دولة لليهود" في فلسطين –
وحتى الآن – تثبت صحة هذه الأقوال وتنسجم معها وقد لاحظنا الفائدة العظيمة التي
جناها اليهود من القرارات الدولية، حيث تقول جولدا مائير عن ذلك باختصار: «لقد
أوجدتنا "الأمم المتحدة" منذ البداية»([16])!!
إننا نستنتج من خلال تعاطي "الأمم المتحدة" مع
"إسرائيل" و"تعاطي إسرائيل مع قراراتها، أننا نعيش في مجتمع دولي
طبقي عنصري لا يعرف للعدالة طريقًا، فيه تتميز دولة عن أخرى رغم المساواة النظرية
بينهما في السيادة والحقوق كما هي موجودة على الورق في "ميثاق هيئة الأمم
المتحدة".
إن هذا المجتمع الدولي هو الذي يسمى بالدول الكبرى التي تؤثر
وتقود "هيئة الأمم المتحدة" حيثما تشاء، وهذه الدول كانت مسؤولة أولًا
وآخرًا عن مصير فلسطين وسلب الحقوق العربية منها. فمن هذه الدول استخدم "حق
الفيتو" لا ليقر الحق، ولا ليقف محايدًا، بل استخدم هذا النفوذ للتمادي في
التأثير على الدول الصغرى وإرغامها على تأييد قرار تشتيت عرب فلسطين وتفتيت
أراضيهم ونهب أموالهم وانتهاك حرمات مقدساتهم([17]).
فمن خلال هذا السلوك الدولي المتميز، الذي كان وراء عقد
الكثير من المؤتمرات الدولية، يمكننا القول: إن هذه المؤتمرات الدولية التي صدر
عنها الكثير من القرارات والتوصيات، لم ترد «حقوقًا مسلوبة لشعب من الشعوب بدافع
أخلاقي، أو إنساني، وغالبًا ما كانت تعقد المؤتمرات الدولية بعد انقضاء الحروب، أو
أحيانًا لتدارك وقوع الحروب، وكانت تتمخض عن نتائج ترضي إرادة ومصالح القوي
المنتصر»([18]).
كما أن رفض "إسرائيل" لكل القرارات الدولية بما فيها رفض فكرة انعقاد مؤتمر دولي لبحث مشكلة الشرق الأوسط جعلها تصر
على أن يكون مؤتمر مدريد (1991) مدخلًا
لإجراء مفاوضات ثنائية مع الأقطار العربية، ودون أن يكون عنده سلطة اتخاذ خطوات
ملزمة للأطراف المشاركة، ودون أن يكون للقرارات الدولية عنصر الإلزام بالنسبة
لإسرائيل وبخاصة في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي ضد أقطار المواجهة العربية،
المتباعدة في إمكانياتها وأهدافها. وقد استطاعت "إسرائيل" عقد اتفاقيات
تسوية ثنائية – منحية جانبًا هيئة الأمم المتحدة – ملائمة للأهداف الصهيونية([19]).
من هنا فإن اليهود لا يلتزمون بالقرارات والمواثيق الدولية
وقد قال عنها اسحق شامير يوم 14أيار 1992: "كلمات فارغة" و"لا قيمة
لها" و"لن تصبح حقيقة أبدًا". وصرح ديفيد لفي أن: «"إسرائيل"
ترفض رفضًا قطعيًا مثل هذه القرارات»([20]).
ولكي
نتعرف على المنهجية الإسرائيلية في التعاطي مع قرارات الأمم المتحدة، لا بد من
الوقوف عند بعض القرارات التي فيها إلزام أو جزء من الإلزام موجه إلى
"إسرائيل". كأنموذج واضح عن السلوك الإسرائيلي ومنهجيته في التعامل مع
القرارات الدولية:
1.
قرار التقسيم:
رقم (181) الصادر عن الجمعية العامة في 29/11/1947 الذي قسم فلسطين ثلاثة أقسام
وهي:
-
قسم تقام عليه "الدولة
اليهودية".
-
وقسم تقام عليه
الدولة العربية.
-
والقسم الأخير
يكون منطقة دولية.
وافقت
"إسرائيل" على هذا القرار من حيث المبدأ على أنه يعترف بقيام دولة
يهودية في فلسطين، لكنها اعتبرته خطوة مهمة نحو تحقيق "إسرائيل الكبرى"
لذا لم تعترف بالحدود التي نص عليها قرار التقسيم حتى قبل صدوره وذلك «حين دار
الحديث في أروقة الأمم المتحدة عن التقسيم، سارعت منظمة "الأرغون" إلى
رفع مذكرة في أيلول 1947 ضمنتها الاعتراضات التي لقنها إياها المعلم
"جابوتنسكي". فانتقدت مشروع التقسيم وأعادت إلى الأذهان مطامع الصهيونية
في شرقي الأردن، ثم خلصت إلى القول بأن أي اتفاق حول موضوع التقسيم لا يلزم الشعب
اليهودي بتاتًا. وقد يكون من المفيد نقل بعض الفقرات التي وردت في المذكرة على
الشكل الآتي:
لا
يمكن لأي وعد يقطعه الزعماء اليهود على أنفسهم بالحفاظ على الحدود التي تجري أن
يبرَّ به، وليس بالإمكان الوفاء به. إن الضغط المتزايد لملايين من التائقين للعودة
وهدفهم الوحيد وضع حد لحياة الذل والمهانة في (الدياسبورا) سوف يتغلب على جميع
العقبات التي قد توضع في طريقهم… إن أرض "إسرائيل" لا يمكن تقسيمها ولا
يجوز، بل من الواجب إعادة توحيدها، فشرقي الأردن تؤلف جزءًا لا يتجزأ من وطننا
الأم، وقد حولت بريطانيا هذا الجزء من بلادنا – تحت ستار منحه الاستقلال – إلى
مستعمرة أخرى من مستعمراتها… إننا نعلن [أن] كل اتفاق يوقعه أفراد أو مؤسسات على
أي مشروع للتقسيم غير الملزم لشعبنا. فتوقيعهم لاغ ولا قيمة له منذ البداية… وكل
معاهدة يجري توقيعها على أساس التقسيم تنقصها صفة الشرعية، ويصبح من حق شعبنا
وواجبه أن يبادر إلى إلغائها»([21]).
إن
ما جاء في مذكرة "الأرغون" لا يعتبر مناقضًا لموافقة ممثل الحكومة الإسرائيلية
على قرار التقسيم، لأن اليهود جميعهم متفقون حول الهدف الذي طرحته المنظمة، ولكن
توزيع الأدوار يقتضي أن يوافق جانب ليرفض الآخر وبخاصة أن الآخر هو جزء من الجيش
الذي يفرض سيطرته على أرض فلسطين، ويتحرك في كل الاتجاهات لتحقيق الأهداف
التوسعية. وبالتالي يكون هذا التوزيع في الأدوار لتعطيل تنفيذ قرار "هيئة
الأمم المتحدة" ونقض لما جاء فيه.
وقد أعلن "بن غوريون" بصراحة منذ صدور قرار التقسيم أن: «الدولة الإسرائيلية
تعتبر قرار الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947، باطلًا كأنه لم يكن»، وبدأ
مهمته في أكبر عملية طرد للمواطنين الفلسطينيين([22]).
ثم صرح "بن غوريون" تصريحًا آخر يعبر فيه عن رفضه للحدود التي نص عليها
قرار التقسيم فقال: «إن الأمر لا يكمن في الإبقاء على الوضع القائم، فنحن في حاجة
إلى دولة حركية مهيأة للتوسع»([23]).
لذا
لم يأت تاريخ انضمام إسرائيل إلى "هيئة الأمم المتحدة" إلا وقد استولت
على الكثير من الأراضي التي جعلها قرار التقسيم من نصيب "الدولة
العربية" إلا أن ذلك لم يحل دون انضمامها إلى تلك الهيئة التي اشترطت لذلك: «أن
تكون الدولة صاحبة طلب الانضمام من الدول المحبة للسلام، وتلتزم بتنفيذ الالتزامات
الواردة فيه»([24]).
وقد وافقت "إسرائيل" على ذلك حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة (273)
الصادر في 11/5/1949 الذي قبل "إسرائيل" عضوًا في "الأمم
المتحدة" وقد ورد في مقدمة القرار أن الأمم المتحدة: إذ تلاحظ أيضًا تصريح
دولة إسرائيل أنها: تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
وتتعهد أن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوًا في "الأمم المتحدة".
إذ
تشير إلى قراريها الصادرين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وفي 11 كانون الأول
(ديسمبر) 1948، وإذ تحيط علمًا بالتصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة
إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة([25]).
وعلى هذا الأساس قبلت عضوية "إسرائيل" في "الأمم المتحدة"!!
ولكن "إسرائيل" نقضت ذلك ونفذت على الأرض سياستها التوسعية الثابتة، فما
إن جاءت حرب (1967) إلا وإسرائيل قد احتلت جميع الأقسام التي نص عليها قرار
التقسيم وجزءًا من أراضي الدول العربية المجاورة تعبيرًا عن حبها للسلام وتأكيدًا
على نقضها للالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة!!
2.
مشكلة
اللاجئين:
برزت
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نتيجة قيام اليهود باغتصاب فلسطين وإعلان
"دولتهم" عليها وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين منها، وذلك منذ حرب
(1948) حيث قامت الحكومة اليهودية والعصابات الصهيونية بإتباع سياسة التطهير
العنصري وذلك عن طريق طرد الفلسطينيين من أرضهم وارتكاب المجازر الوحشية بحقهم
التي تجعلهم يفرون بأرواحهم من الإرهاب الصهيوني المنظم الذي يقوم على أسس عقدية
منبثقة من التوراة والتلمود حيث يوصيهم إلههم بطرد "الغوييم" من بينهم
لاستحالة العيش المشترك فيقول لهم: «إن لم تطردوا أهل الأرض من أمامكم، يكونوا من
تبقونه منهم كمخرز في عيونكم وكشوكة في خواصركم، يضايقونكم في الأرض التي أنتم
مقيمون بها. فأفعل بكم كما نويت أن أفعل بهم»([26]).
وقد ترجمت الحركة الصهيونية هذه العقيدة إلى سلوك وممارسة فعلية على أرض فلسطين من
أجل إقامة "الدولة اليهودية" الخالية من "الأغيار"، لأن أرض
فلسطين وفق مزاعمهم هي "أرض الميعاد" وهي من حقهم وحدهم، ونتيجة لهذه
السياسة التي اتبعها اليهود في فلسطين فرّ أكثر من ستمائة ألف فلسطيني من ديارهم
خلال حرب (1948) ولجئوا إلى البلدان العربية، وسمي هؤلاء باللاجئين الفلسطينيين،
وأصبحت مشكلتهم عالمية لم تجد لها حلًا إلى غاية الآن، برغم الاهتمام الدولي بها
لاسيما "هيئة الأمم المتحدة"، التي اتجهت في علاجها لهذه المشكلة «اتجاهين
واضحين: الأول سياسي، والآخر اقتصادي. ومنذ طلب "برنادوت" إدراج مشكلة
اللاجئين في أجندة الدورة الثالثة "لهيئة الأمم المتحدة"، ولا تكاد تخلو
منها دورة واحدة من دورات "هيئة الأمم" ابتداء من سنة 1948. حيث يعرض
التوتر بين العرب وإسرائيل» ([27]).
ولكن أهم قرار اتخذته "هيئة الأمم المتحدة" كان في عام 1948 في دورتها
الثالثة برقم (194) الذي يعتبر الأساس لكل القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة
التي تعالج مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لذا يعتبر هذا القرار (194) «مرجعًا
قانونيًا دوليًا، ثابتًا، يتضمن تعريفًا واضحًا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة
جماعية، ويطالب بحقهم في العودة كمجموعة قومية. أو في التعويض للذين لا يرغبون في
العودة»([28]).
وقد
نص القرار (194) بالحرف على ما يلي:
«إن
الجمعية العامة، وقد بحثت الحالة في فلسطين من جديد:
تقرر
وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم
والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب وضع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة
إلى بيوتهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون
الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر
تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد
وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال
الوثيق مع مدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله مع الهيئات
والوكالات المناسبة في منظمة الأمم المتحدة»([29]).
ومن
خلال القرار (194) أوكلت "هيئة الأمم" تنفيذ هذا القرار إلى "لجنة
التوفيق" التي أنشأتها من ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا
وتركيا لتتخذ الخطوات التي تعاون الهيئات المعنية حتى تصل إلى حل للمشكلة. ولتحمي
الأماكن المقدسة وتسهل عودة اللاجئين الراغبين في العودة إلى فلسطين([30]).
ولكن
"إسرائيل" سرعان ما ورفضت تطبيق
القرار (194)، وضربت بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات
"الأمم المتحدة" و"مجلس الأمن" وظهر لها موقف لحل مشكلة
اللاجئين يناقض ما ورد في القرارات الدولية، «فأثناء دورات "لجنة التوفيق
الدولية" (1948-1951) التابعة للأمم المتحدة، كانت تسوية قضية اللاجئين من
أبرز العقبات التي واجهتها جهود اللجنة، وكان الطرح الإسرائيلي كما لخصه رأي
"بن غوريون" في لقاء له مع أعضاء اللجنة هو أن: «حكومة إسرائيل ترى أن
الحل الصحيح للجزء الأكبر من مسألة اللاجئين في إعادة توطينهم في الدول العربية…
وفي الشروح الإسرائيلية لهذا الموقف الجامح، كانت عملية إدماج في المجال العربي،
اقتصاديًا وسياسيًا، تنطلق بدورها من تفضيلات معينة منها:
-
أن يجري توطين اللاجئين في نقاط بعيدة عن جغرافية "إسرائيل" من
الناحية الإقليمية، فإن لم يكن ذلك ممكنًا، فإن الأردن يمثل مكانًا مناسبًا لهذا
الحل ذلك أن دفع اللاجئين بعيدًا إلى داخل العالم العربي، يقطع فكرة التواصل مع
الوطن والحنين إليه ويزيل فكرة العودة من رؤوسهم.
-
إن إدماج
اللاجئين في إطار إقليمي عربي أمر يتسق ومبدأ "أنهم عرب سوف يعيشون بين
عرب"، والمنطقة العربية مليئة بالموارد التي تمكن من استيعابهم. وفي هذا
الإطار لن يعاني اللاجئون من صدمة لغوية أو قومية أو ثقافية حضارية»([31]).
.
قضية القدس:
تناول قرار التقسيم (181) 29 تشرين الثاني 1947
مدينة القدس وجعلها تحت «نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع "للأمم
المتحدة"، وذلك وفقًا لدستور خاص يضعه للمنطقة المدوّلة»([32]).
ونص القرار (194) الصادر في 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق للأمم المتحدة وتقرير
وضع القدس في نظام دولي ([33])..
ومن أهم النقاط التي حددتها "هيئة الأمم المتحدة" لتوضيح مهمة
"لجنة التوفيق" كانت «العمل على إنشاء نظام دولي دائم للأراضي المقدسة
وتقديم ضمانات كافية لحماية الأماكن المقدسة والوصول إليها»([34]).
وقد جاءت موافقة "إسرائيل" على الالتزام بهذه القرارات الدولية في قرار
قبولها عضوًا في الأمم المتحدة رقم (273) الصادر في 11/5/1949. وكان التزامها
بتنفيذها شرطًا أساسيًا لقبول عضويتها في هيئة الأمم. ثم جاء قرار الجمعية العامة
رقم (303) (الدورة الرابعة) بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 1949، تحت عنوان
"إعادة التأكيد على وضع القدس تحت نظام دولي دائم".
وقد
نص هذا القرار (303) على ما يلي:
«أولًا:
تقرر فيما يتصل بالقدس، مؤمنة بأن المبادئ التي تقوم عليها قراراتها السابقة
المتعلقة بهذه المسألة وخصوصًا قرارها الصادر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947،
تمثل تسوية عادلة ومنصفة للمسألة:
1.
أن تعيد لذلك،
إعلان غايتها في وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجد ضمانات ملائمة لحماية
الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها، وأن تؤكد بالتحديد الأحكام التالية من قرار
الجمعية العامة رقم (181) (الدورة 2):
-
ينشأ في مدينة القدس كيان منفصل تحت حكم دولي خاص تقوم على إدارته الأمم المتحدة.
-
يعين مجلس الوصاية ليضطلع بمسؤوليات السلطة الإدارية…
- وتضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية
بالإضافة إلى القرى والبلدان المحيطة بها، بحيث تكون أبو ديس أقصاها غربًا… وتكون
شعفاط أقصاها شمالًا…
ولكن سرعان ما جاء الرد الإسرائيلي، حيث «أعلن بن غوريون –
رئيس الوزراء يومذاك – بتصريح قال فيه: استنسبت الأمم المتحدة … هذا العام أن تقرر
أن تصبح مدينتنا الخالدة كيانًا منفصلًا تحت إشراف دولي: إن رفضنا لهذه التوصية
الشريرة كان حازمًا وباتًا، فقد انتقلت الحكومة والكنيست فورًا إلى القدس وجعلتها
تاج إسرائيل، وعاصمتها، وبشكل لا يقبل الإلغاء ليراه الناس أجمعون»([35]).
وهذه الخطوة التي أعلن عنها بن غوريون، صدّق عليها الكنيست الإسرائيلي في 23 كانون
الثاني 1950 أي بعد شهر ونصف تقريبًا من صدور قرار الجمعية العام (303) المتعلق
بوضع القدس تحت نظام دولي. ولا شك أن إصرار "إسرائيل" على اعتبار القدس
منذ تلك الفترة المبكرة من تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي عاصمة لها، إنما كان
يخفي وراءه رغبتها في السيطرة على كل المدينة فور أن تواتيها الفرصة المناسبة([36])
وقد تحقق لها ذلك في حرب حزيران 1967 حيث استولت "إسرائيل" على كامل
مدينة القدس، التي يعتبرها اليهود جزءًا مهمًا من تاريخهم الذي يجب استعادته من
جديد لإعادة بناء "هيكل سليمان"، حيث يقول بن غوريون: «لا معنى لإسرائيل
بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل»([37]).
وهكذا بقيت القدس في الخطاب السياسي والديني الإسرائيلي
العاصمة الأبدية لإسرائيل التي لا يجوز التنازل عنها!! مهما تعددت القرارات
الدولية التي لا قيمة لها أثناء الممارسات اليهودية على أرض الواقع. فقد قام
الكنيست الإسرائيلي عام 1980 بالموافقة على نقل مقر رئيس الجمهورية الإسرائيلية
إليها، وذلك في محاولة لإجبار سفراء الدول على تقديم أوراقهم إليه هناك، حيث تؤدي
هذه الخطوة إلى اعتراف دول العالم بأن القدس عاصمة "إسرائيل".