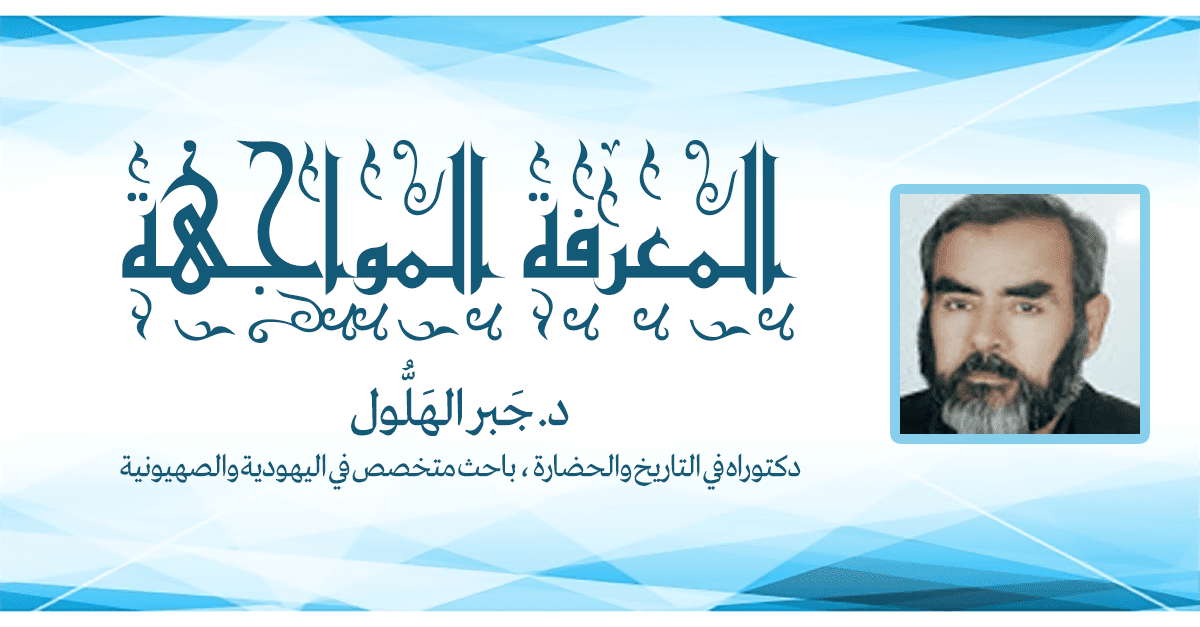المنهجية
الصهيونية في الاعتماد على القوى الخارجية
(العصا التي
يتوكأ عليها اليهود عبر التاريخ)
الدكتور جبر
الهلّول
إن الدارس لحركة اليهود عبر التاريخ يجد أن الديانة
اليهودية في جوهرها مشروع استعماري ضخم يتوقف وجوده على الارتباط الوثيق بقوة
خارجية هي بالتأكيد أكبر بكثير من القوة التي يتمتع بها لكي تسانده وتدعمه وتضمن
له الحماية التي توفر له مناخ الاستمرارية في عملية التكوين والبناء التي يحتاج
إليها.
وتلك الحاجة إلى القوة بالنسبة للمشروع اليهودي ضرورة
اقتضتها طبيعة المشروع ذاته من حيث كونه فكرة ولدت عن طريق الوعد بمنح قوة خارجية تمثلت
بالإله "يهوه" "لأبرام" ومن ثم لنسله من بعده بتمليكه أرضًا
مسكونة، ولا يمكن تحويل هذه الفكرة إلى واقع إلا بمساندة تلك القوة الخارجية لها.
وإذا كان "يهوه" وفق العقيدة اليهودية قد
اختار "شعبه" من بين شعوب الأرض، ووضع لهم مشروعًا استعماريًا يقع على
عاتقهم تنفيذه، وأعطاهم المشروعية الدينية للقيام بكل ما يتطلبه، فإنه ألزم نفسه
بتنفيذ وعده مباركة ومشاركة فعلية وتحيزًا تامًا لهم، وصب جام غضبه على كل الشعوب
من غير اليهود لاسيما الذين يقفون في وجه مشروعه، وبخاصة سكان تلك الأرض التي
سلبها منهم ليعطيها "لشعبه الخاص".
وإذا كان يبدو للوهلة الأولى أن الإله "يهوه"
باعتباره قوة خارجية قد تبنت تنفيذ المشروع اليهودي بكليته واحتضانه احتضانًا
أزليًا، فإنه لا يعدو كونه منهجًا يهوديًا جبلوا عليه. فهم الذين اختاروا إلههم
وفق مواصفات العدائية التي تربوا عليها، من حيث كونه إلهًا محاربًا باطشًا يحب سفك
الدماء، ولكنهم أظهروه وكأنه هو الذي اختارهم وقربهم حتى كادوا جزءًا منه، فمنحهم
وعده الأزلي، وتبنى تحقيق مشروعهم على سبيل الاختيار والاصطفاء لهم، من دون جهد
وطلب وحاجة اضطرتهم في كثير من الأحيان إلى التذلل والخضوع واستجداء كل وسيلة
تقربهم من تلك القوة عساهم كسب بعض فتاتها بما يخدم مصالحهم ومشروعهم.
وقد برع اليهود
في منهجيتهم من حيث رصد مواطن القوة والعمل على استمالتها بشكل يوحي أن تلك القوة
تحت تأثير قوتهم الخفية التي تسيطر على موطن صنع القرار ذاته فيها، وإخفاء الصورة
الحقيقة لحالة الضعف التي يعيشون فيها، حيث إن قوتهم مهما بلغ حجمها غير قادرة على
تحقيق أدنى درجة من طموحاتهم وأحلامهم، وأن تلك القوة متى تخلت عنهم لحقهم الدمار
والفشل وعادوا للعيش في ذكريات الماضي وهواجس المستقبل. ولعل تاريخهم وفق ما صوروه
وسطروه شاهد على مدى تعلقهم وارتباطهم بالقوة الخارجية.
- اليهودية والحاجة للقوة الخارجية :
قبل أن يصبح الاعتماد على القوة الخارجية استراتيجية
متبعة عند اليهود وتقليدًا مستمرًا في سلوكهم وجزءًا مهمًا من تفكيرهم، فإن حاجتهم
إلى تلك القوة وتعلق مصير طموحاتهم وأحلامهم بها هي ترجمة لحالة الضعف التكوينية
والبنيوية في نشأتهم وواقعهم عبر التاريخ. فاليهود كمجموعة بشرية لها عقيدتها
وتصوراتها عن الحياة والكون هي صاحبة مشروع استعماري كبير أكبر من قدرتهم وقوتهم.
إذ يستحيل عليهم تنفيذ مشروعهم من دون الاعتماد على قوة خارجية، فهم قلة قليلة في
مواجهة كثرة عددية، بالإضافة لاعتبارهم أن كل "الأغيار" هم أعداء
محتملون في كل زمان ومكان، إلا أنهم مضطرون إلى رصد مواقع القوة فيهم ووضع أنفسهم
تحت رعايتها ووصايتها طلبًا للمساعدة والمساندة والحماية.
ولعل تعلق اليهود بالإله "يهوه" كقوة خارجية
يأتي في مقدمة تلك القوة ومثالًا يوضح منهجية اليهود في التعامل معها أينما حلوا
وارتحلوا ومتى وجدت وكيفما وجدت. فالإله الذي يتعهد "لأبرام" بتمليكه
أرضًا مسكونة والعمل على مساعدتهم في إخراج أهلها منها وإبادتهم، مقابل بضعة أوامر
عليهم الالتزام بها تتلخص بالخضوع التام له وتنفيذ إرادته واحترام وصاياه، تخفي
الصورة الحقيقية "لأبرام" الذي كان وحيدًا مهاجرًا من أرض إلى أرض يبحث
عن مستقر يأويه، فلم يجد غير قوة الرب قوة خارجية قادرة على مساعدته يتفق معها
مقابل عهد يكشف عن واقع حاله ومتطلباته، فبينما القوة الخارجية المتمثلة "بالرب"
لم تشترط عليه سوى قطع "الغلفة" من أبدانهم، أي قطع قطعة لحم قذرة من
أبدانهم مقابل قطع قطعة أرض تدر لبنًَا وعسلًا تمتد من الفرات إلى النيل!. ;كما ورد في كتابهم
تحت عنوان "العهد والختان"(1).
فمنذ ذلك العهد بين "أبرام" والإله
"يهوه" أصبح اليهود لا يتحركون حركة إلا بتخطيطه ومساعدته مباشرة،
وبخاصة أثناء الحرب عندما يكونون مترددين خائفين بسبب حالة الضعف التي يعيشون فيها(2)، فيقول لهم
مطمئنًا ومذكرًا أنه معهم: «إذا
خرَجتُم لِلحربِ على أعدائِكُم، فرَأيتُم خيلًا
ومَركباتٍ معَ جيشٍ أكثَرَ مِنكُم، فلا تخافوا مِنهُم لأنَّ
معكُمُ الرّبَّ إلهَكُم الذي أخرَجكُم مِنْ أرضِ مِصْرَ. 2وعِندَ اَقْتِرابِكُم
مِنْ ساحةِ الحربِ يتَقَدَّمُ الكاهنُ ويُكلِّمُ الشَّعبَ 3بقولِهِ: «إسمَعوا يا
بَني إِسرائيلَ! أنتُمُ اليومَ تقتَرِبونَ لِمُحاربةِ
أعدائِكُم.
لا تضعَفْ قُلوبُكُم ولا تخافوا ولا تبتَعِدوا ولا تُعرِضوا
عَنهُم، 4لأنَّ الرّبَّ إلهَكُم سائرٌ معَكُم لِيُحارِبَ أعداءَكُم عَنكُم ويُخلِّصَكُم»(3).
وإذا
كانت علاقة اليهود مع "يهوه" كقوة خارجية معنوية هي أنموذج لعلاقتهم مع
كل قوة مادية يمكن أن يستفيدوا منها في واقعهم المعاش، ويجب عليهم الخضوع التام
لها، فإن هذا الوجوب لا يعني التقصير في أخذ الحيطة والحذر والرصد بشكل دقيق
لتحولاتها من طرف لآخر، آخذين بالحسبان أن الخطأ في هذا المجال سيكلفهم خسران كل
ما جنوه من مكاسب وهدم كل ما بنوه من مخططاتهم ومشروعاتهم، ولعل خطأهم في عدم
سماعهم لنصيحة أحد أنبيائهم "إرميا" ما زالت تؤرقهم ويتجرعون مرارة
نتائجها، وذلك عندما أخبرهم عن نبوءته (4)..
وخلاصة ما كان
بين "إرميا" وقومه يتعلق حول أية قوة ستنتصر على الأخر في حال الصدام
المتوقع بين "الكلدانيين" و"المصريين"، فبينما رأى
"إرميا" أن النصر سيكون حليف "نبوخذ نصر" وجيشه، لذا يجب
المسارعة للانضواء تحت نيره قبل بدء المعركة، بينما رأى قومه أن النصر سيكون
للمصريين، لذا لم يسمعوا لقول "إرميا" الذي اضطر إلى أن يحتال للاتصال
بجيش "نبوخذ نصر" ويجري معه مفاوضات مطولة، بينما هم ظلوا على قناعتهم
حتى اقتحم "نبوخذ نصر" القدس وساقهم أسرى إلى بابل، في حين قدر
"لإرميا" موقفه فترك له الحرية في البقاء أو الهجرة، وقد كان يخشى على
نفسه من قومه، فهاجر سرًا، لكنهم لم يلبثوا أن قتلوه، وأحدث ذلك صدمة كبيرة لهم،
ومن ذلك اليوم وهم يراقبون بدقة وحذر "مراكز القوة" من أجل معرفة النجم
القوي الصاعد، للانضواء تحت ظله من دون مراعاة لاعتقاده وسلوكه، حيث لا يبصرون فيه
سوى القوة التي يقدسونها ما دامت موجودة فيه.(5)
فالخطأ في تقدير القوة الصاعدة بالنسبة لليهود كان
قاتلًا ومدمرًا لفترة طويلة من الزمن، وربما هذا الخطأ كان وراء لهاثهم المستمر
وراء القوة الخارجية بدءًا من "كورش" الذي بسبب تآمرهم معه في القضاء
على "نبوخذ نصر" سمح لهم بالعودة إلى فلسطين. وهكذا كان ديدانهم مع كل
قوة ناشئة عبر التاريخ، حيث يتقلبون من حضن إلى آخر، وقد ورثت الصهيونية هذه
المنهجية وهذا التقليد عند اليهود وباتوا يتنقلون من قوة استعمارية إلى أخرى
يستجدونها ويضعون أنفسهم تحت نيرها.
- الصهيونية والقوة الخارجية:
إن الصهيونية خرجت "بأيديولوجيتها" السياسية
من رحم الفكر الديني اليهودي بما في ذلك "الاتكالية" على القوة الخارجية
لتحقيق مخططاتها ومشروعها الاستعماري في فلسطين. وإذا كانت القوة الخارجية في
الفكر الديني اليهودي قد تمثلت بشكل أساسي "بـ "يهوه" الذي يتكل
عليه اليهود في تحقيق الخلاص الذي ينتظرونه، فإن الصهيونية طرحت أيديولوجيتها على
أساس التعجيل في تحقيق الخلاص عن طريق الاتكال على القوة الخارجية الاستعمارية
التي لها أطماعها في المنطقة التي من ضمنها فلسطين، حيث بات الاعتماد على تلك
القوة في أغلب الأحيان أكثر من قوة الرب ذاته.
وقد اصطلح على تسمية "الاعتماد على الغير" في
التاريخ السياسي "بالمناورة الخارجية" التي يعرفها "ياسين
سويد" بقوله: «.. بأن يعتمد فريق (أو طرف) في نزاعه السياسي أو العسكري ضد
فريق (أو طرف) آخر، على فريق ثالث يسانده ويدعمه في هذا النزاع كي يغلبه على الفريق
الخصم، وهو ما اعتمده بنو إسرائيل [اليهود] طيلة تاريخهم»(6)، وكذلك
الصهيونية التي أدخلت "المناورة الخارجية" في صلب استراتيجيتها منذ
نشوئها، وأثناء العمل على قيام دولة "إسرائيل"، ولا تزال إلى اليوم، ولا
يمكنها التخلي عنها مستقبلًا لارتباط مصيرها فيها(7).
وبالعودة إلى بداية نشاط الحركة الصهيونية نجد مؤسسيها
بذلوا جهدًا كبيرًا ونشاطًا مكثفًا بين القوى الاستعمارية المتنافسة والمتصارعة
على الساحة الدولية للارتماء في أحضان بعضها، وللارتهان لمن يظهر تفوقه على تلك
الساحة. فقد تمحور نشاط "هرتسل" في لقائه أغلب قادة العالم القوي في تلك
الفترة، ومناشدتهم تحقيق الحلم الصهيوني بفلسطين ليضع الأسس العملية في كيفية
الاعتماد على القوة الخارجية والاهتمام بها، واعتبارها السبيل الوحيد لبناء
"الدولة اليهودية وتطويرها وحمايتها. وقد «ترأس "هرتسل" في حياته،
ستة مؤتمرات صهيونية، كان آخرها في عام (1903)، وفي تلك المؤتمرات تم إرساء الأسس
السياسية والمادية لحركة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، وتم التأكيد في تلك
المؤتمرات على أن إنجاح وتنفيذ المشروع الصهيوني مرهون بتبني قوة استعمارية له،
لتكون سندًا قويًا له، وتضفي على الحركة الصهيونية ومشروعها صفة الشرعية»(8). وقد صرح
"ماكس نوردو" مساعد الزعيم الصهيوني "هرتسل" حول هذه المسألة
بقوله: «إن أمانينا تتجه نحو فلسطين، كما تتجه البوصلة نحو الشمال. لذا ينبغي أن
نوجه أنفسنا صوب تلك القوى...التي يتصادف أن تكون فلسطين في دائرة نفوذها»(9).
لقد ركزت الحركة الصهيونية نشاطها منذ لحظة كونها فكرة
ومن ثم حركة فدولة قائمة على أرض الواقع على الدول الاستعمارية، وبخاصة أن زعماء
الصهيونية قد كانوا على دراية تامة بحقيقة الأطماع الاستعمارية لتلك الدول فأرادوا
أن يستغلوا ذلك الظرف في خدمة مشروعهم، وقد برعوا ونجحوا في نقل خطواتهم بين تلك
الدول. ومن تلك الخطوات رغبتهم «في استغلال جميع الدول، وفي دفع بريطانيا إلى
الحرص على تحالفها وفي إخفاء هذا التحالف أنشأت الصهيونية عام (1908) في استنبول
وكالة صهيونية تعمل لحساب ألمانيا... كما أنشأت فيها جريدة "تركيا الفتية"
تهاجم فيها بريطانيا وتدعوا الصهيونيين للاعتماد على ألمانيا ضد انجلترا. وفي
أعقاب قيام الثورة التركية "الاتحاد والترقي" جاء إلى استنبول من برلين
"الفريد نوسينج" وحاول إقناع الأتراك بإسكان اليهود في فلسطين والعراق،
مقابل بذل الصهيونية ومؤازرتها ـ خاصة المالية ـ لتركيا الفتية. وتقول مصادر
السفارة البريطانية في استنبول آنذاك أنه كان لليهود أثر بالغ في تسيير دفة الأمور
في تركيا»(10).
فزعماء الصهيونية ركزوا نشاطهم على منافذ القوة الدولية
وحاولوا جعل خطواتهم متوازية لكسبها إلى جانب مشروعهم، وللإطلاع عن قرب عن تصاعد
القوة المتنافسة والمتصارعة، وفي أي جانب سيكون تفوقها وسيطرتها. وضمن هذه
الاستراتيجية أقاموا في برلين « ما يعرف "لجنة الشرق" متظاهرين بالعمل
على انتصار ألمانيا. يساعد هذه اللجنة منظمتان: الأولى في (كوبنهاجن) والأخرى في
(استنبول). وفي الولايات المتحدة الأمريكية أقاموا "اللجنة الأمريكية
المؤقتة" إضافة إلى المنظمة القائمة فعلًا برئاسة "وايزمن" في
بريطانيا. وفي تركيا أقاموا اللجنة الصهيونية التنفيذية لخدمة الأغراض نفسها. كانت
هذه محاولات لازمة في اجتهاد زعمائها للاحتفاظ لأنفسهم ولحركتهم بخط رجعة سليم
وللعمل بثقلهم في الجانب الرابح ليطالبوه بنصيبهم من الأرباح عند الحساب.
لكن الصهيونية كانت تعتمد على بريطانيا كل الاعتماد
بوصفها الدولة الاستعمارية الأولى (في ذلك الحين)، وكان زعماء الصهيونية على تفهم
تام لمخطط بريطانيا الاستعماري في إقامة حاجز بشري .. قوي غريب..»(11) في المنطقة
العربية للفصل بين الجانب الآسيوي منه والجانب الأفريقي!!.
وبما أن زعماء الصهيونية
كانوا يدركون
أن من بين هذه الدول المتنافسة والمتصارعة سوف يبرز الأقوى، وهذا الأقوى هو الذي
يفرض سياسته على الآخرين باعتبارها المنهج والقانون الذي يجب أن يتبع في العلاقات
الدولية من دون
الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة الضعيفة وحقوقها. كما كانوا يدركون،
أن التقاء مصالح الدول القوية وتشابكها يؤدي إلى تحالفها الذي يشكل بحد ذاته القوة
الدولية التي تضع "القانون العام" الذي يحكم مصالحها وأهدافها في الدول
المستهدفة وبالتالي هي التي تستطيع أن تصنع الرأي العام الذي تريده.
ومن هنا نستطيع أن نفهم تحرك "هرتسل"
الكثيف بين الدول الأوروبية والدولة العثمانية – مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين – من أجل الحصول على دعم لمشروعه التوسعي في بناء "الدولة
اليهودية". وأكد ذلك عندما طرح تصوره لحل "المشكلة اليهودية"
فقال: «… إنها قضية قومية يمكن حلها فقط
عندما تعالج كقضية سياسية عالمية تناقشها شعوب العالم المتحضر في مجلس دولي»(12). وقال في موضع آخر: «إن ملاذات العالم
المسيحي يجب صيانتها بتحديد مكانة إقليمية إضافية لها مما هو معروف في قانون
الأمم. وعلينا أن نشكل حرس شرف حول هذه الملاذات بغرض تحقيق هذا الواجب فيما يختص
بوجودنا. وسيكون حرس الشرف هذا هو الرمز العظيم لحل المشكلة اليهودية بعد ثمانية
عشر قرنًا من معاناة اليهود»(13).
فعلى هذا المبدأ وعلى هذه القاعدة سار "هرتسل"
والقادة الصهيونيون من بعده، واستطاعوا في كثير من الأحيان أن يصلوا بمطالبهم أو
بمشاركتهم الشخصية إلى الكثير من المؤتمرات وكانت
أولى نجاحاتهم في مؤتمر "كامبل بانرمان" الاستعماري، الذي عقد في عام
1905 في لندن بصورة رسمية وسرية بعد
سقوط حكومة "آرثر بلفور"، وقد استمرت جلسات المؤتمر تنعقد حتى عام 1907. وكان قد دعا إليه حزب المحافظين، وقدمت
توصيات إلى حكومة الأحرار برئاسة "هنري كامبل بانرمان". وكان هدف
المحافظين إقناع رئيس الوزراء الجديد "كامبل مانرمان" بالعمل على تشكيل
جبهة استعمارية من الدول الأوروبية وهي: إنكلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا،
البرتغال، بلجيكا وهولندا، وذلك لمواجهة الأطماع الاستعمارية التنافسية، ولتحقيق
بعض الأهداف التوسعية في إفريقيا وآسيا.
وعملًا بهذه
التوصيات تأسست لجنة عليا مختصة في الشؤون الاستعمارية مؤلفة من الأعضاء المشتركين
في الجبهة الاستعمارية، واجتمعت في لندن عام 1907 هذه اللجنة التي ضمت كبار
العلماء في التاريخ والاجتماع والاقتصاد والزراعة والجغرافية والبترول. وانتهى
تقرير المؤتمر عام 1907 إلى ضرورة توطيد الاستعمار في المناطق التي تسيطر عليها
الدول المشاركة في المؤتمر، كبريطانيا في إفريقيا والهند والشرق الأقصى، وإيطاليا
في ليبيا، وإسبانيا في المغرب وجزر المحيط الأطلسي، وانتهى المؤتمر أيضًا إلى
قرارات تقضي بالتوسع في مناطق أخرى من آسيا وإفريقيا(14).
وقد جاء في
التوصيات «العاجلة التي قدمها مؤتمر لندن الاستعماري لرئيس الوزراء "كامبل
بانرمان" حيث أكد المؤتمرون
ضرورة فصل الجزء الإفريقي من المنطقة العربية عن جزئها الآسيوي وضرورة إقامة
"الدولة العازلة" Buffer
State إذ أن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط
أوروبا بالعالم القديم ويربطها معًا بالبحر المتوسط بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى
مقربة من قناة السويس قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها هو
التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة. وكانت هذه التوصية تعني أمورًا
عديدة منها:
1. أن الإشارة إلى زرع شعب غريب في شرقي قناة السويس أي في
سيناء وفلسطين باعتبارهما منطقتين وحيدتين يمكن أن تفصلا عرب آسيا عن عرب إفريقيا،
هذه الإشارة تعني مباشرة الشعب اليهودي.
2. كان تقرير مؤتمر لندن عام 1907 بمثابة "الضوء
الأخضر" للسياسة البريطانية والحركة الصهيونية في انتزاع فلسطين عن سائر
الوطن العربي، لخلق نواة استعمارية تؤمن استمرارية النفوذ الاستعماري في المنطقة.
3. لم يكتف التقرير بضرورة إيجاد "الدولة اليهودية"
في فلسطين بل رأى أن الضمانة الأكيدة لاستمرار النفوذ الاستعماري في المنطقة
العربية هو ضرورة إيجاد ظروف التقسيم والتفكك والتناحر بين الشعب العربي.
4. إن تقرير المؤتمر الاستعماري يعني حتمية الصراع بين مجموعة
الدول التي اشتركت في المؤتمر من جهة وبين ألمانيا والدولة العثمانية من جهة أخرى.
ذلك لأن النتائج التي توصل إليها خبراء اللجنة العليا، أوضحت أنه لا يمكن الوصول
إلى تجزئة العالم العربي وتقسيمه إلا بعد إقامة دولة عنصرية غريبة في المنطقة، ولا
يتم ذلك أيضًا إلا بعد تصفية الدولة العثمانية. وكان ذلك مستحيلًا ما لم يتم
القضاء على ألمانيا – الطامعة في الشرق- لأن أي صدام مع الأتراك يعني الصدام مع
ألمانيا»(15).
فالتوصية التي
قدمها مؤتمر لندن (1907) إلى كامبل بانرمان" تعبر عن رأي الجبهة الاستعمارية
المؤلفة من: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال وبلجيكا وهولندا. وهذه
الدول تؤلف باجتماعها القوة الدولية المسيطرة في بداية القرن العشرين، وما يصدر
عنها من قرارات وتوصيات تعتبر قرارات وتوصيات دولية تستلزم منها التنفيذ. والملاحظ
من هذه التوصية أن الحركة الصهيونية استطاعت التحرك بين أطماع هذه الدول وإقناعها
بطموحاتها وأهدافها التي تشابكت مع أطماع تلك الدول. وأصبحت "المشكلة
اليهودية" كما يسميها هرتسل مطروحة أمام الدول الكبرى المسيطرة لإيجاد حل لها
يتناسب مع تطلعاتهم الاستعمارية. فكانت التوصية من قبل المؤتمر أول نجاح للحركة
الصهيونية على الصعيد الدولي، وأول قرار دولي تجاه اليهود، وبذلك تحقق حلم هرتسل
بطرح المشكلة اليهودية على «شعوب العالم المتحضر ـ على حد زعمه ـ في مجلس دولي»!!(16).
وفي هذا المجلس الدولي قوى استعمارية متنافسة فيما بينها، وقد بدا واضحًا للصهيونية
أن فلسطين من ضمن أطماع "بريطانيا" الاستعمارية، وأن بريطانيا تظهر
تفوقًا بقوتها عن باقي الدول الأخرى وتفرض إرادتها عليها، لذا يجب تركيز النشاط
الصهيوني عليها لاحتضان مشروعهم ورعايته. وقد أثمر ذلك صدور "وعد بلفور"
بمنحهم فلسطين لإقامة الدولة اليهودية عليها، وتعهد الحكومة البريطانية بتنفيذ ذلك
الوعد ورعاية اليهود والعطف عليهم!!.
فقادة الحركة الصهيونية وضعوا مشروعهم منذ لحظة بدء تنفيذه تحت وصاية
ورعاية وحماية القوة البريطانية، واستمر ذلك إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية
حيث ظهرت قوة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة متفوقة على الساحة الدولية، فتحولوا
للارتماء في أحضانها لإكمال ما بدأه البريطانيون من مشروعهم، مستغلين ثورة القوة
الأمريكية ونزعتها للسيطرة على المنطقة وتفردها فيها، وحاجتها إلى قواعد تخدم
تطلعاتها وسياستها الخارجية.
ويمكن القول: إن المشروع الصهيوني قد ارتكز على قوتين خارجيتين رئيستين
هما: القوة البريطانية قبل إعلان قيام الدولة الإسرائيلية، ومن ثم على القوة
الأمريكية بعد إعلان قيام الدولة، ولكن لا يعني هذا عدم اعتماده على قوى خارجية
أخرى، ورصده لقوى أخرى ناشئة يمكن أن يكون لها شأن في المستقبل. ومن تلك القوى
نذكر:
1-
القوة الفرنسية: لم يغفل زعماء الصهيونية القوة
الفرنسية على اعتبارها قوة استعمارية منافسة للقوة البريطانية، فقد استطاعوا من
خلال تغلغلهم في الحياة الفرنسية السياسية كسب تأييد «فرنسا لإصدار وعد
يخول اليهود استيطان (فلسطين)، حيث تمكن الزعيم الصهيوني (ناحوم سوكولوف) بواسطة
زعماء اليهود الفرنسيين أن يحصل على موافقة الحكومة الفرنسية المبدئية من خلال
رسالة بعثها "جيل كامبو" سكرتير عام وزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة في
(4 حزيران عام 1917)(17) أي قبل صدور
"وعد بلفور" بـ (خمسة أشهر)»(18). كما نجحت الصهيونية
بالحصول على موافقة فرنسا للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار
الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين عام 1947 بين العرب واليهود. كذلك اعتمدت على
فرنسا وبريطانيا وبالتنسيق معهما بشن حرب عام 1956 ضد مصر. واعتمدت على فرنسا
أيضًا للحصول على المساعدات العسكرية لاسيما في مشروعها النووي(19).
2-
القوة السوفيتية: إن "الاتحاد السوفيتي" ـ
سابقًا ـ كان الخزان البشري للمشروع الصهيوني إذ أنه من المعلوم أن أعظم نسبة من
اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين كانت منه. ولم يكن ليتحقق ذلك التهجير المكثف
والسماح به لولا الجهد الصهيوني والتغلغل اليهودي داخل قيادة "الاتحاد
السوفيتي نفسه. وقد اتضح ذلك بجلاء أثناء قيام الثورة السوفيتية عام (1917) التي
أصدرت قرارًا ذي شقين بحق اليهود، وهما:
1-
اعتبار عداء اليهود جريمة يعاقب عليها قانونًا.
2-
الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.
فهذا القرار تأييد صريح لوعد بلفور ودعم عملي للمشروع الصهيوني في فلسطين،
وقد تجلى هذا الدعم بالوقوف وراء صدور قرار تقسيم فلسطين عام (1947)، والاعتراف
بقيام "دولة إسرائيل" بعد يومين من إعلانه في (15 أيار 1948)، وكان بذلك
الاعتراف ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا. وكانت
مؤازرة الاتحاد السوفيتي إلى جانب الولايات المتحدة سببًا لقبول
"إسرائيل" عضوًا في الأمم المتحدة عام 1949.(20)
-
الاستراتيجية الصهيونية والقوى الخارجية:
يدرك الصهاينة أهمية الاعتماد على حليف في عملية بناء المشروع الصهيوني،
وأن هذا الاعتماد يشكل ضمانة وجودية له على كل المستويات العسكرية والسياسية
والاقتصادية. وقد جاء في مقال كتبه "أبراهام تامير" في صحيفة
"هآرتس" (20/9/1998): «...إن بناء جيش "الدفاع الإسرائيلي" في
عام (2000) مرهون بحجم المساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية
لإسرائيل وذلك اعتمادًا على عناصر الردع في الوقت الحقيقي وأقصد الردع الاستراتيجي
لحماية الوجود والكيان وزرع استراتيجية طويلة المدى بواسطة طائرات هجومية وقوات
برية وجوية وبحرية، وضمان أمن السكان في مواجهة الإرهاب من البر والبحر والجو في
مواجهة أسلحة الدمار الشامل. إن قدرة إسرائيل على مواجهة الأخطار التي تحدق
بكيانها والقضاء عليها، مرهونة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة منظمة
للتعاون والأمن لدول الشرق الأوسط والعلاقات المتبادلة بين هذه المنظمة وبين
الأنظمة المتعددة الجنسيات التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي»(21). فالهدف من الاعتماد على القوة الخارجية لاسيما اليوم الولايات
المتحدة الأمريكية على حد تعبير "تامير" «حماية الوجود والكيان»، وذلك
لأن المشروع الصهيوني هو في محنة كيانية مادام موجودًا ولن يكون الخلاص لتلك
المحنة إلا بالقضاء على الطرف الآخر أو بالقضاء عليه ـ وهذا لن يتحقق قريبًا ـ لذا
ستبقى الحاجة في الاعتماد على القوة الخارجية في صلب الاستراتيجية الصهيونية
وفلسفتها في الوجود. لذا كما يقول أحد الكتاب اليهود "أفرايم سنيه":
«ينبغي أن نخطط لمكانة إسرائيل في عالم ما بعد ألفين ليس فقط في السياق الإقليمي
الضيق، ولا حتى في سياق المدى الاستراتيجي أيضًا، بل ينبغي أن نستقصي علاقات
إسرائيل مع عناصر القوة العالمية القديمة والجديدة في آن واحد»(22).
فإذا كانت استراتيجية الاعتماد على القوة الخارجية تعتمد على الإدراك
للأخطار المستقبلية المحدقة وكيفية مواجهتها، فإن الحركة الصهيونية أدركت أهمية
الارتباط بالقوة الخارجية لتحويل المشروع الصهيوني من فكرة إلى واقع على الأرض.
وكانت تدرك أيضًا أن هذا الواقع المفروض لن يلقى القبول في المحيط الذي زرع فيه،
وسيبقى يعيش ضمن محيط معاد لا يمكن له المواجهة منفردًا، كذلك لا يمكن له القيام
بالأعباء المترتبة على هذا الوجود ما لم يتم الاعتماد على قوة خارجية قوية. «وقد
أوضح "إيجال آلون" مدى أهمية هذه المسألة بالنسبة لإسرائيل، وتحديدًا
التحالف مع إحدى الدول الكبرى، بقوله: «إننا لا بد لنا من المحافظة على صداقة دول
كبرى وعلى رأسها الدول التي من شأنها أن تزودنا بوسائل القتال، والمساعدات
السياسية والمعونات الاقتصادية». وفي مطلع كانون الأول (1966) حدد "أبا
إيبان" وزير خارجية إسرائيل العوامل والضمانات التي تعطي لإسرائيل أملًا قي
البقاء وفق الترتيب التالي:
أ- استمرار المساعدات العسكرية
الأمريكية المباشرة ...
ب- استمرار حماية الدول الكبرى للوضع
القائم.
ت- استمرار الخلافات العربية، لأنه لو
اتحد العرب، لما بقي أحد يهتم بنا، ولسهل عليهم إذابة كياننا،...»(23).
فالحاجة إلى الضمانات التي تعطي أملًا في البقاء وتحقق نوعًا من الطمأنينة
في مواجهة الخوف المستمر في المستقبل هو جوهر الاستراتيجية الصهيونية في اعتمادها
على قوة خارجية بل إلى عدة قوى خارجية، لأنه على حد تعبير "شمعون بيريز"
«الدولة الصغيرة التي تتأثر كثيرًا بالتحولات السياسية الدولية، يجب عليها أن
تحتفظ على الدوام بقدرتها على المبادأة/ المباغتة. وأن تسعى بشكل جدي للحصول على
نماذج أخرى من الضمانات، غير ضمانة القدرة هذه، وأن تتبع سياسة جماعية في
ارتباطاتها الدولية»(24). وقد نجحت
الصهيونية (وإسرائيل) بتحقيق أكبر عدد ممكن من الضمانات الدولية لاسيما في
الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين كل أنواع الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي،
ولتوفير الحماية الأمنية لوجودها وقوتها في مواجهة المحيط المعادي لها، وقد ساعدها
على هذا النجاح، إدراكها الدقيق لحقيقة الموقف الدولي ومتغيرات توازن القوة فيه
وتحولاتها. وقد كان لها من وضوح الرؤية بما تمتلك من قدرة أن توطد علاقاتها بالدول
ذات السلطة العالمية، أي الدول التي تمتلك القرار الدولي، بدءًا من بريطانيا في
بداية طرح فكرة المشروع الصهيونية والخطوات العملية لتنفيذه وانتهاء اليوم
بالولايات المتحدة الأمريكية، من دون سواها. حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية
اليوم بدور البلد الأم الحاضن للمشروع الصهيوني بكل حذافيره(25). حتى «بات واضحًا أن لأمريكا الفضل في بقاء إسرائيل وتوسعها، وإن
دولة إسرائيل.. لا يمكنها البقاء ولو لأسبوع واحد من دون المساعدات الأمريكية
المالية والعسكرية ومن دون تأييد الولايات المتحدة الأمريكية السياسي والمعنوي
المطلق لها في المحافل الدولية، تحت تأثير هيمنة الصهيونية العالمية، وبتحريض من
الغرب الصليبي وتشجيع منه، ..»(26).
فالاعتماد على الدول الكبرى مبدأ أساسي في الاستراتيجية الصهيونية ولا يمكن
لها الاستغناء عن هذه الاستراتيجية وتطويرها بحسب مقتضيات الظروف الإقليمية
والدولية، ولكن هذا لا يعني إغفال الاهتمام بالقوى الأقل شأنًا وتوسيع دائرة
العلاقات الخارجية مع أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات والمعسكرات الموجودة على
الأرض. وقد قال "بن جوريون" إن: «على الأوروبيين أن يقتنعوا، شاؤوا أم
أبوا، أن إسرائيل بسبب وضعها في "الشرق الأوسط" هي موقع متقدم للغرب في
المنطقة، إنها الحدود الطبيعية "للعالم الحر"، فمن يضمن حدود إسرائيل؟
أليس فرنسا؟ أليس بريطانيا؟ أليس الولايات المتحدة ؟!.
يجب تجاوز الجغرافيا. . يجب أن تمتد المنظمات العسكرية الغربية إلى الشرق
الأوسط لتشمل إسرائيل..وما تريد إسرائيل هو تحالف عام مع "الحلف
الأطلسي"».
يقدم "بن جوريون" المشروع الصهيوني كمشروع يخدم التطلعات
الاستعمارية للدول القوية، ولا يستطيع القيام بمهامه ما لم يتلق الدعم والحماية
الكاملة منها, مقرًا بأن تلك الدول ـ فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ـ هي التي
تحمي حدود "إسرائيل" المؤقتة، وأن اليهود من دون الاعتماد على تلك القوى
الخارجية لا يمكنهم البقاء على تلك الأرض، ولا يمكنهم الاستمرار في عملية البناء
لمشروعهم الاستعماري في المنطقة.
فإسرائيل في الحقيقة والواقع ما هي إلا دولة شاذة مريضة لا يمكن لها أن
تستمر في الحياة من دون حقنات مستمرة ومنتظمة من كميات الدولارات الضخمة، ودفقات
من المهاجرين ورعاية وحماية من دولة نظامية قوية تؤمن لها ذلك، مقابل أن تكون في
خدمة المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة.(27)
(2) ياسين سويد: ياسين سويد :التاريخ
العسكري لبني إسرائيل من خلال كتابهم ، ط1 ، شركة المطبوعات ، بيروت ، 1998. ج2،
ص193.
(12) هرتسل: الدولة اليهودية، ترجمة محمد يوسف عدس، مراجعة ودراسة عادل حسن غنيم، ط1،
دار الزهراء، مصر، 1996، ص 43.
(14) د. حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة
الصهيونية، ط1، جامعة
بيروت العربية،1978، ص 221-222.
(17) وقد جاء في هذه الرسالة: «لقد
تفضلتم بتقديم المشروع الذي تكرسون جهودكم له، والذي يهدف إلى تنمية الاستعمار
اليهودي في فلسطين، إنكم ترون أنه إذا سمحت الظروف من ناحية، وإذا توافر ضمان
استقلال الأماكن المقدسة من ناحية أخرى، فإن المساعدة التي تقدمها الدول المتحالفة
من أجل بعث القومية اليهودية في تلك البلاد التي نفي منها شعب إسرائيل منذ قرون
عديدة ستكون عملًا ينطوي على العدالة والتعويض...إن الحكومة الفرنسية... لا يسعها
إلا أن تشعر بالعطف على قضيتك التي يرتبط انتصارها بانتصار الحلفاء، إنني سعيد
لإعطائك مثل هذا التأكيد». (انظر: أحمد الزغيبي: العنصرية اليهودية، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1998، ج4، ص61-62)
(20) مجلة استراتيجية: العدد (صفر) شتاء 1991، خالد
ياسين: نظرة تاريخية في علاقات إسرائيل الدولية، ص66-68.
(23) مجلة الأرض: العددان (1-2)، كانون الثاني وشباط،
1992، إبراهيم عبد الكريم، (الاعتماد الإسرائيلي على حليف) ، ص4-5.
(27) جاك دومال و ماري لوروا: التحدي
الصهيوني" أضواء على إسرائيل"،ط1 ترجمة نزيه الحكيم، دار العلم للملايين،
دار الآداب ، بيروت، 1968، ص 109-110.