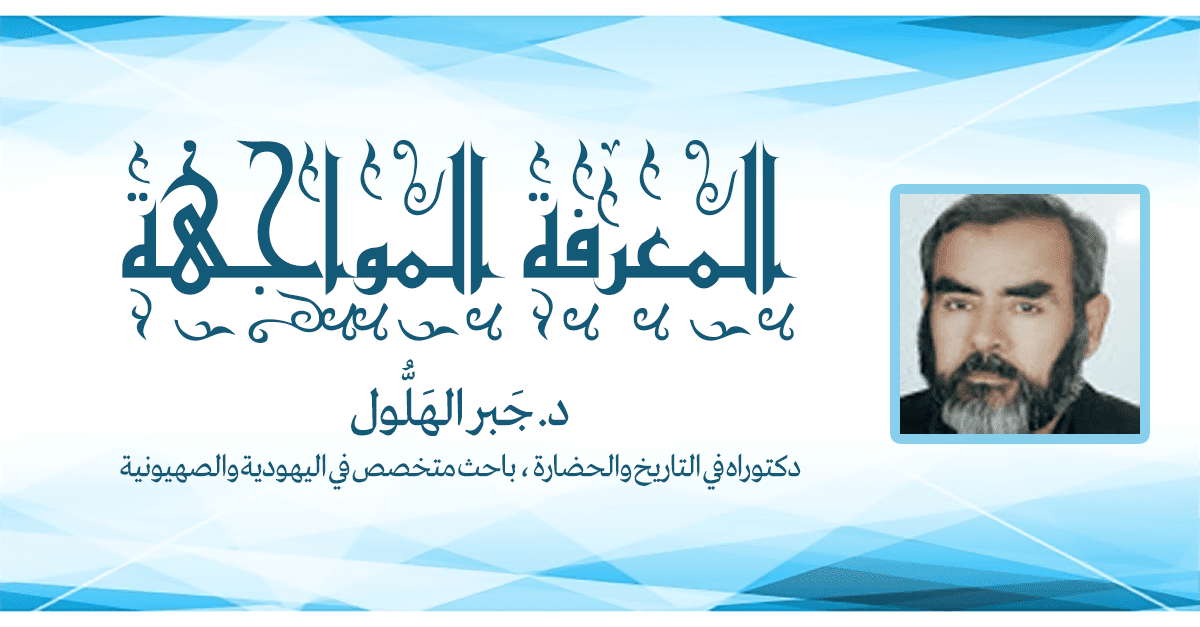الأجنبي
في الشريعة اليهودية (هالاخاه)
الدكتور
جبر الهلّول
إن
مجزرة "شفا عمرو" التي ارتكبها جندي صهيوني ضد مجموعة من الفلسطينيين،
ومن قبلها مجزرة "الحرم الإبراهيمي" التي نفذها "باروخ جولد
شتاين" وما سبقهما من مجازر تكاد لا تحصى بحق الفلسطينيين هي ترجمة عملية
لتعاليم الشريعة اليهودية بحق الآخر غير اليهودي، لاسيما الفلسطيني كعدو مباشر
وتاريخي. وقد قال حاخام يهودي عند تأبينه " جولد شتاين": «إن مليون عربي
لا يساوون ظفر يهودي واحد»([1])،
وتبعًا لفتوى حاخامات إسرائيل، فإن "شتاين" «غير مذنب بل هو مبعوث
العناية الإلهية الذي نفذ وصايا التوراة» تلك الوصايا التي تنمي في الشخصية
اليهودية العدائية تجاه الآخر، وقد عبر عن ذلك "جولد شتاين" نفسه بقوله:
«إن العرب مثل الوباء، سئمناهم.. هؤلاء العرب مثل الوباء.. إنهم الجراثيم التي
تنقل إلينا الأمراض»، وأضاف: « إن اليهود مثل الحملان بين سبعين ذئبًا..إننا نخدع
أنفسنا عندما نفكر أنه من الممكن التعايش معهم.. إنه أمر مستحيل»([2]).
فأعمال
القتل التي يمارسها اليهود تجاه الآخر ليست عملًا مدانًا، ولا ينظر إليها على أنها
عمل إجرامي يستحق فاعلها العقاب، وإنما هي أعمال مباركة من قبل "الرب"
لأنها تطبيق للواجب الذي تفرضه الشريعة اليهودية، وفاعلها يستحق الثناء والتكريم
لجرأته وشجاعته في تنفيذ ذلك الواجب. كما وينظر إلى الذين يقومون بتلك الأفعال
نظرة إعجاب وتقدير وثناء، ويصبحون قدوة للأجيال القادمة اليهودية ومحط افتخارهم
واعتزازهم، وإذا ما قتلوا أثناء قيامهم بأفعالهم تلك يصبحون "شهداء"
وقبورهم تصبح مزارات مقدسة يؤمها اليهود.
ويخطئ
من يظن أن تلك الأفعال الإجرامية التي ترتكب بحق الفلسطينيين مصدرها اليهود الذين
ينتمون إلى حركات أصولية يهودية متدينة، أو حركات صهيونية يمينية متطرفة، أو أنها
أعمال فردية شاذة يرتكبها جندي يهودي، أو مستوطن يهودي بمعزل عن السلوك اليهودي
العام النابع من الشريعة اليهودية التي هي القانون الناظم لحياة اليهود عبر
التاريخ، لاسيما بعدما أمست لهم دولة يجتمع فيها عدد كبير من اليهود، وسلطة تأخذ
مشروعيتها من تلك الشريعة، وتمتلك القدرة على تطبيقها، وتشجع المجتمع اليهودي على
الالتزام بقوانينها، وتربية الأجيال على مبادئها وقيمها الأخلاقية العنصرية
المستوحاة منها.
فمن
يقوم بمثل مجزرة " شفا عمرو" أو مجزرة "الحرم الإبراهيمي" أو
المجازر في "مخيم جنين" أو في "قانا" أو في "صبرا
وشاتيلا" وصولًا على مجزرة "دير ياسين".. هو: وفق المعايير
اليهودية يهودي ـ سواء كان فردًا أم مجموعة ـ ملتزم بتعاليم الشريعة اليهودية وعمل
على تطبيق وتنفيذ تعاليمها التي تتعلق بالآخر غير اليهودي لاسيما الفلسطيني الذي
هو العدو المباشر له على اعتباره يحتل القسم الأهم من "أرض الميعاد" التي
يحلمون بالسيطرة عليها مع إنجاز مراحل المشروع الصهيوني بكاملها.
وطالما
الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام تفرضها شريعة على أتباعها فلا يصح أن تختزل المسألة
بتجريم شخص هو وفق تصور المجموعة التي ينتمي إليها يقوم بالواجب الذي تفرضه شريعته
عليه، وإنما يجب النظر إلى الأمر على أنه تعبير عن حالة التزام اليهود بشريعتهم
تجاه الآخر، وأن هذا الالتزام في حالة تنامي مستمر، قد يخف التعبير عنه في حالات
الشعور بالثقة والاستقرار، وقد يتصاعد بشكل كبير في حالات القلق والخوف من
المستقبل، لكنه في كل الحالات هو "سلوك مقدس" متأصل في الشخصية اليهودية
وممارساتها الحياتية ويطمح كل يهودي إلى القيام به!!.
وهذا
يقودنا إلى القول: بأن ما يقوم به اليهود من أفعال إجرامية تجاه الفلسطينيين ليست
وليدة فعل وردة فعل آنية من دون ارتباطها بمرتكزات نفسية أو تاريخية أو عقدية جعلت
منها جزءًا راسخًا في بنية الشخصية اليهودية، تغذيها على الدوام العقيدة التوراتية
التلمودية التي أصبحت مرتكزًا أساسيًا للمشروع الصهيوني، وتقننها الشريعة اليهودية
عن طريق قوانين وفتاوى حاخامية تلبي شهوة القتل والعدائية المتأصلة تجاه الآخر غير
اليهودي. ويقول "فرويد" عن الوصية التوراتية "لا تقتل": «والتأكيد
ذاته على الوصية "لا تقتل" تجعل من اليقيني أننا ننحدر من سلالة من
المجرمين لا نهاية لها. كانت الشهوة إلى القتل تجري في عروقهم كما يمكن أن يكون
الحال معنا نحن أنفسنا»([3]).
ولهذا
من المفيد التذكير بأهم الواجبات الشرعية التي تفرضها الشريعة اليهودية على
أتباعها وتوجب عليهم القيام بها تجاه الأجنبي التزامًا بأوامر الرب
"يهوه" كسبًا لرضاه واجتنابًا لغضبه، على النحو التالي:
حياة الأجنبي معدومة
القيمة بالنسبة لليهود:
إن
قتل يهودي بحسب الشريعة اليهودية جريمة عظمى وإحدى الخطايا الثلاث البشعة (إلى
جانب الإشراك والزنا)، لكن في المقابل «إن قتل غير اليهودي لا يعد جريمة عندهم، بل
فعل يرضي الله!»([4]).
وجاء
في التلمود: «اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، وحرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من
باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بذلك يكون حفظ حياة أحد
الوثنيين»([5]).
وقال "ميماوند": «إنه يلزم قتل الأجنبي، لأنه من المحتمل أن يكون من نسل
السبعة شعوب. (الذين كانوا في أرض كنعان المراد قتلهم من قبل اليهود ولم يقتلوهم
عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم ألأرض) وعلى اليهودي أن يقتل من تمكن من
قتله، فإذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع!!»([6]).
لذا من المفروض على اليهود قتل كل أجنبي إذا تمكن منه، وإذا لم يتمكن فيجب عليه أن
يتسبب في هلاكه في أي وقت، أو على أي وجه كان، لأن التسلط على اليهود سيدوم مادام
واحد من الكفار على قيد الحياة. ولذلك جاء من يقتل أجنيًا يكافأ بالخلود في الفردوس
والجلوس هناك في السراي الرابعة. أما من قتل يهوديًا فكأنه قتل العالم أجمع، ومن
تسبب في خلاص يهودي فكأنه خلص الدنيا بأسرها([7]).
ووفقًا
لأحكام الشريعة اليهودية التي تستبيح حياة الأجنبي ماله وعرضه ودمه فقد جاء في
كتاب وزعته قيادة الجيش الإسرائيلي على الجنود في مطلع السبعينات من القرن الماضي
فتوى حاخامية مستواحاة من تلك الشريعة تجعل من قتل العرب رجالًا كانوا ونساء ليس
مسموحًا به فقط ولكنه واجب ديني. وتطبيقًا لتلك الشريعة فقد تعاملت الإدارة
اليهودية مع المجرمين الذين قاموا بجرائم بشعة بحق العرب كمن يقوم بجنحة صغيرة أو
مخالفة مرور، فالمحامي اليهودي "شموئيل لاهيس" المسؤول عن قتل (50-70)
من الفلاحين العرب منح العفو التام بعد محاكمة شكلية، وقد تدخل "بن
جوريون" شخصيًا لاستصدار عفو عنه، ثم عين هذا المجرم عام (1978) مديرًا
"للوكالة اليهودية"([8]).
مع العلم أن القوانين الجنائية في "إسرائيل" لا تميز بين اليهود وغيرهم
فإن الحاخامات يوجهون أتباعهم إلى الالتزام بالتعليمات اليهودية في مواقعهم.
وإذا
كانت تعاليم الحاخامات المستوحاة من الشريعة اليهودية بشأن حياة الأجنبي تتعارض،
من حيث المبدأ، مع قانون الجزاء في "إسرائيل"، فإنها بلا أدنى شك تبسط
نفوذها وسيطرتها على القضاء، لاسيما القضاء العسكري الإسرائيلي. لأنه في جميع
الأحوال التي قتلَ فيها يهود، عربًا مسالمين، ضمن سياق عمل عسكري أو شبه عسكري ـ
بما في ذلك حالات المذابح الجماعية الكثيرة ـ فإن القتلة، وفي الحالات التي لم
يبرؤون فيها، كان الحكم عليهم بعقوبات خفيفة للغاية ثم تخفض حتى لتصبح كأنها لا
شيء([9]).
أما
المجتمع اليهودي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فإنه ينظر نظرة إعجاب وتقدير
للفاعل سواء كان فردًا أم مجموعة منظمة، لأنه ينفذ وصايا الرب التي يتحقق فيها
الخلاص اليهودي القائم أصلًا على فكرة الإبادة للآخر الأجنبي وفرض السيطرة عليه
وإخضاعه للشريعة اليهودية والاحتكام إليها. أما الإبادة فإنها تتعلق بشكل مباشر
بالأجنبي الذي يعيش على "أرض الميعاد"، وأما فرض السيطرة والإخضاع فإنها
تتعلق بالأجنبي الذي يعيش خارج "أرض الميعاد".
والإبادة
للأجنبي الذي يعيش داخل "حدود إسرائيل" هي تعبير مختصر لما تفرضه
الشريعة اليهودية على اليهود القيام به. وإن كانت الإبادة تعني القتل الجماعي
والمجازر الوحشية فإنها تعني أيضًا استئصال الآخر وسلبه حق الحياة ومستلزماتها، من
سفك لدمه وهتك لعرضه وسلب لماله وأرضه وقسره على الهجرة من وطنه طردًا وتشريدًا
ونفيًا إلى بقاع متباعدة عنه.
قوانين خاصة
"بأرض إسرائيل":
إن
الشريعة اليهودية تحرم على اليهود أن يبيعوا الأملاك غير المنقولة ـ كالبيوت
والحقول ـ في "أرض إسرائيل" للأجانب. ويسمح لهم فقط تأجير بيت لأجنبي
بشرطين. أولًا، ألا يستخدم البيت للسكن، ولكن لأهداف أخرى، كمستودع مثلًا.
وثانيًا، ألا تؤجر على هذه الشاكلة ثلاثة بيوت متجاورة أو أكثر. وتفسر هذه القاعدة
على نحو إن لم يتملكوا أرضًا فإن إقامتهم عليها ستكون مؤقتة. كما إن الوجود المؤقت
للأجانب لا يمكن التساهل فيه إلا عندما يكون اليهود في المنفى، أو يكون الأجانب
أشد قوة من اليهود، ولكن عندما يكون اليهود أشد قوة من الأجانب، كما هو الحال
اليوم في فلسطين فإنه من المحرم عليهم الإبقاء على الأجانب يعيشون بين ظهرانيهم،
لأنه مكتوب: "لن يسكنوا بلدك"([10]).
ولهذا، وبحسب الشريعة اليهودية، يجب أن يعرف اليهود كيف يعاملون الفلسطينيين،
وينزعون منهم أرضهم متى امتلكوا القدرة التي تمكنهم من فعل ذلك([11])!!.
فالقضية
الأساسية التي تتمحور حولها الشريعة اليهود فيما يتعلق بالأجنبي هي
"الأرض" التي يجب أن يجتمع عليها اليهود لإقامة الدولة اليهودية التي كل
رعاياها من اليهود أو في غالبيتهم، ولا يسمح لغيرهم البقاء فيها إلا بقدر حاجاتهم
الخدمية وازدياد نموهم الديموغرافي وبلوغهم من القوة ما يمكنهم من السيطرة على
أكبر مساحة ممكنة من الأرض التاريخية "الموعودة". وإن الأرض التي
يحتلونها منها يحرم عليهم التنازل عن ملكيتها للأجنبي.
وإذا
كانت هناك بعض القرارات السياسية الصهيونية في التخلي عن بعض الأراضي التي احتلها
اليهود كسيناء والانسحاب من الجنوب اللبناني على اعتباره جزء من "أرض
إسرائيل" فإن القرار السياسي لا يلغي الحكم الشرعي اليهودي، ويبقى القرار
السياسي في إطار المناورة السياسية والخطة الاستراتيجية في عملية تنفيذ المراحل
للمشروع الصهيوني. وتأكيدًا على ذلك، لا يمكن لأي زعيم صهيوني سواء كان من الليكود
أو العمل أن يصرح بأن الأرض التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي هي أرض غير
"إسرائيلية"، بل على العكس من ذلك تمامًا يصرحون علنًا بأنها "أرض
إسرائيلية" ويتنازلون عنها من أجل السلام. مع العلم أن هذا التنازل مؤقت بما
يتناسب مع مفهوم "سلام الوسيلة" الذي يخدم بناء المشروع الصهيوني وتعزيز
قوته وتثبيت وجوده في المنطقة. لأن "سلام الهدف" الذي يسعى اليهود إلى تحقيقه
لا يكون إلا بالسيطرة اليهودية الكاملة على "أرض الميعاد" وقيام دولتهم
اليهودية عليها. أي ما يتنازلون عنه اليوم لحاجة ظرفية مؤقتة لابد من استعادته
تنفيذًا لأحكام الشريعة اليهودية. وكما قال
"رفائيل إيتان" وزير الزراعة الإسرائيلي في حكومة نتنياهو: «...وإسرائيل
التي قامت على الاستيطان سوف تواصل النضال على نفس الطريقة، من أجل تقريب اليوم
الذي نرى فيه إسرائيل الكبرى .. بحدودها التوراتية المعروفة!!» ([12]).
الأجنبي هو المشكلة
في غزة:
إن
أحكام الشريعة اليهودية التي تتعلق بالأجنبي الذي يعيش على أرض غزة لا تتناقض مع
القرار الإسرائيلي السياسي في الانسحاب منها إذا علمنا أبعاد هذا القرار ومغزاه. وبالعودة إلى وثيقة "اتفاق أوسلو"
عام (1993) نجد إسرائيل في المرحلة الانتقالية ستنسحب من قطاع غزة ومنطقة أريحا
كما هو مبين في البروتوكول المرفق كملحق رقم (2) ([13]).
وهنا تثار عدة أسئلة: لماذا الانسحاب من غزة أولًا؟ وهل انسحاب إسرائيل منها
تنازل إسرائيلي ومكسب فلسطيني أم هو استراتيجية يهودية في عملية بناء المشروع
الصهيوني؟ وللإجابة على هذه الأسئلة لا بد من معرفة كيف ينظر اليهود إلى غزة؟
ولمعرفة
ذلك نستعرض بعض أقوال زعماء اليهود حول غزة:
-
عندما زار دافيد بن
غوريون غزة للمرة الأولى قال: «لو بقي ذلك الزمان الذي كانت تتدلى فيه المعجزات من
السماء، لكان لدي رجاء وحيد، أن تختفي هذه المدينة».
-
وقال أبا إيبان:
«النهاية قد تأتينا من هناك [أي غزة]» ([14]).
-
وقال رابين: «إن
الكوابيس تطبق عليه كل ليلة بسبب غزة، وإنه يحلم أثناء نومه في بعض المرات أن قطاع
غزة قد وقع في البحر وغرق بكل ما فيه ومن فيه، لكنه يستيقظ من حلمه ليكتشف أن غزة
ومن فيها ما زالوا حيث هم»([15]).
-
وقال شمعون بيريس: «…
إن قطاع غزة يشمل مساحة 365 كيلومترًا مربعًا وبنفوس تقارب 800 ألف نسمة. إن غزة
ليست أرضًا، فهي ليست مأهولة فحسب بل تسجل الرقم القياسي في العالم من ناحية كثافة
السكان… فالأراضي ليست هي المشكلة التي يتعين أن نتعاطى معها، بل المشكلة هي
علاقتنا المقبلة مع سكانها، وإن الذين يتحدثون عن إلحاق الأراضي إنما يقصدون في
الواقع ضم شعبها، بكل ما يترتب على ذلك من عواقب ديموغرافية وسياسية بعيدة الأمد
على كامل المستقبل القومي لإسرائيل، وهويتها بوصفها الدولة الواحدة للأمة اليهودية
وحكومتها الديمقراطية وليس من باب المصادفة أن يهوذا والسامرة وغزة لم تلحق
بإسرائيل حتى عند ما كانت حكومة الليكود هي الطرف المسيطر…»([16]).
فالكثافة السكانية في غزة تشكل مصدر
القلق في تفكيرهم في مستقبل "إسرائيل" ولذا اعتبروها القنبلة
الديمغرافية الضاغطة في غزة أخطر من الجغرافيا التي يتمسكون بها. ومن هنا لا بد من
التسوية التي تنهي هذه المشكلة، ولكن لماذا؟ ويجيب عن هذا السؤال باحث يهودي في دراسة
أعدها عام 1985 تحت عنوان "إسرائيل نحو العام (2000) أربعة قرارات حاسمة
وصعبة"، فقال: «لنبدأ بمسألة الهوية. كلنا يصف ويحدد هوية إسرائيل على أنها
دولة يهودية، ولكن، منذ العام 1967، أصبح نحو 35 في المائة من السكان في المجال
الخاضع لسيطرة إسرائيل من العرب. بعض هؤلاء – نحو 700 ألف – هم من العرب مواطني
دولة إسرائيل وهم يشكلون 17 في المائة من مجموع سكانها، وبقيتهم – نحو المليون
وربع المليون- من العرب الفلسطينيين والأردني الجنسية في يهودا والسامرة وعديمي
الجنسية في قطاع غزة.
ما هو مغزى أن تكون الدولة يهودية، بينما
نحو 35 في المائة من سكانها من غير اليهود؟!
فهل حقًا لها أن تعتبر نفسها يهودية أم
أنها تتحول عمليًا إلى دولة ثنائية القومية؟ وماذا عليه جوهر العلاقات بين الشعبين
القاطنين فيها؟ هل ستكون علاقات قائمة على أساس المساواة في الحقوق وفقًا لما هو
محدد في وثيقة الاستقلال 1948، تلك المساواة في الحقوق التي تطبقها الدولة بشكل
متزايد بالنسبة إلى مواطنيها العرب؟ أو علاقات قائمة على أساس سيطرة أحد الشعبين
على الآخر بالقوة العسكرية، أي علاقات قائمة في أساسها على الرفض، أو على الأقل،
تقليص حقوق نحو المليون وربع المليون من الفلسطينيين.
الموضوع ينوء بالتناقضات الصعبة… ومن
التناقض في الهوية اليهودية لإسرائيل نصل إلى تناقض في طابعها الديمقراطي… وليس
هناك إمكان معقول في أن يتنازل الفلسطينيون وأحفادهم عن هويتهم الفلسطينية.
وبالتأكيد، لا يجب أن نتوقع تطورًا كهذا خلال السنوات [المقبلة]… هذه هي إذن،
مركبات القرار الحاسم الأكثر صعوبة، التي ستواجهها إسرائيل في السنوات المقبلة
...، فيما يتعلق بمستقبل المناطق: هو أن تكون دولة يهودية أم دولة ثنائية القومية؟
وهل تكون دولة ديمقراطية أو دولة لا تطبق الديمقراطية على جزء من سكانها؟ وهل، وكيف
تتقدم نحو حل القضية الفلسطينية دون المساس بأمن الدولة؟ وكيف تحول دون الوصول إلى
طريق مسدود في العملية السياسية؟ ذلك الوضع الذي إن عاجلًا أو آجلًا، قد يدفع دولًا
عربية للتكاتف وشن الحرب»([17]).
هذا الكلام ينسجم مع قواعد الفكر الديني
والفكر السياسي اليهودي المعاصر، ولا يتناقض مع أحكام الشريعة اليهودية، ويعبر عن
حقيقة المشروع الصهيوني، ويتوافق تمامًا مع ما قاله شمعون بيريس سابقًا الذي يدعي
أنه أول من طرح فكرة غزة أولًا، بقوله: «كنت أول من طرح فكرة غزة، أولًا، وكان ذلك
عام 1980، وقتها اعتقدت بأن الأمور ستكون أفضل لو استطعنا التوصل إلى اتفاقية على
مرحلتين، غزة أولًا، ثم الضفة الغربية بعد ذلك([18])…
ولكن هناك قول بأن الفكرة طرحت قبل ذلك على الرئيس السادات سنة 1977 من قبل الجانب
الأمريكي الذي نقلها بدوره إلى ياسر عرفات، وفي ذلك الوقت رفضت من قبل منظمة
التحرير. ولكن ما بين 1977 و1993 تغيرت الأوضاع بشدة وأصبح ما كان مرفوضًا بالأمس
مطلوبًا اليوم([19]).
ولكن الدور الأساسي يعود إلى "شمعون بيريس" لأنه المحرك الأساسي لهذه
الفكرة الذي استطاع أن يحققها في "أوسلو" ويتخذ القرار الحاسم بالاتفاق
مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رابين بأن تكون إسرائيل "دولة
يهودية"، لتطبق الديمقراطية على اليهود فقط! ويحل القضية الفلسطينية فيقزمها
باتفاق "غزة أريحا أولًا".
لقد استطاعت إسرائيل أن تحقق الهدف
الأعمق من الاتفاق بإيجاد نظام فصل عنصري بين اليهود الذين يعيشون على أرض إسرائيل
وبين العرب الذين يعيشون على "أرض إسرائيل" يقوم بتنفيذه مجلس الحكم
الذاتي في تلك المناطق المتفق عليها لإراحة إسرائيل من أية مسؤوليات تجاه سكان تلك
المناطق. وكفاءة نظام الفصل العنصري ستضمنها السلطة الفلسطينية من جهة، والمساعدات
المالية الدولية التي ستمنح لها، من جهة أخرى([20]).
وهذا النظام هو أحد البدائل المؤقتة للتطهير والإبادة التي ابتدعها الفكر الصهيوني
المستمد من الشريعة اليهودية ليحافظ على "نقاوة الدم والحضارة"
اليهودية، حينما لم يستطع أن يطرد ويبيد كل العرب من فلسطين فلجأ عن طريق المخادعة
إغراء القيادة الفلسطينية … بإنشاء محميات عربية على بقع محدودة من "أرض
إسرائيل" تكون الأرض فيها جزءًا لا يتجزأ من "أرض إسرائيل" وكذلك
السماء والماء فوق الأرض والطبقات السفلى تحت الأرض، ويقيم عليها جماعات محدودة
العدد من الفلسطينيين (قد لا تصل إلى الربع) تدير شؤونها المعيشية والبلدية بنفسها
ضمن إطار من الأنظمة والقوانين التي يصفها الإسرائيليون ويشرفون على التقيد بها.
وزيادة في حشر هذه المحميات، تكون
متناثرة بحيث يحاصرها "الإسرائيليون" من جوانبها مثلما يشرفون على طرق
المواصلات فيما بينها، أي إذ "الاستقلال الفلسطيني" المزعوم حسب اتفاق
أوسلو وما تلاه من اتفاقات إنما هو تطهير عرقي ونظام فصل عنصري لغالبية الأراضي
الفلسطينية، وجاءت تطبيقاتها العملية من خلال بناء الجدار العازل وخطة شارون لفك
الارتباط.
لقد عجز الإسرائيليون، حتى الآن، عن
إنجاز عملية المجتمع اليهودي الصافي والنقي، باستمرار وجود حوالي المليون عربي في
الأراضي التي جرى احتلالها عام 1948، وبإنشاء المحميات العربية على أراضٍ سقطت عام
1967… أما العرب المقيمون فقد وجد الصهيونيون مخرجًا مؤقتًا لاستمرار وجودهم إلى
أن تسنح لهم الفرص بطردهم تطبيقً للشريعة اليهودية.
إذن، فالمجتمع اليهودي في فلسطين أصبح
قادرًا، على أن يطل على يهود العالم مرجعًا وحيدًا وشرعيًا لحمل مسؤولية القرار عن
كل يهود العالم أينما كانوا والى أي شعب انتسبوا. وهكذا تطورت إسرائيل، في مائة
عام، من "دولة اليهود" (كما سماها هرتزل وجعلها عنوانًا لكتابه الشهير)
لتصبح الآن على طريق الدولة اليهودية، أي الكيان العنصري النظيف الخالي من عيوب
الاختلاط ودنس الدخلاء ومشاركة الآخرين والأغيار ([21])!
فاتفاق
"أوسلو" الذي نص في أحد بنوده على الانسحاب من غزة جاء محققًا كل
المصالح والطموحات اليهودية وملبيًا لكل ضوابط ومواصفات مقولة التقاسم الوظيفي
الصهيونية. وهذا ما أشار إليه شمعون بيريس بعد توقيع الاتفاق أثناء مناقشته في
"الكنيست" بقوله: «إن حكومة حزب العمل لم تتخل في قطاع غزة عن الأرض،
وإنما تخلت عن مئات الآلاف من السكان»([22]).
لأن الأرض يحرم التخلي عنها مطلقًا لكن التنازل المؤقت عن السيطرة عليها لظرف ما
كأن يكون الأجنبي أكثر عددًا فيها يصعب استئصاله منها، أو لمصلحة عظمى ترجع
بالفائدة على غالبية اليهود ومشروعهم الاستعماري.
فالانسحاب
من غزة في إحدى صوره هو تعبير عن مشكلة الأجنبي الذي يعيش فيها وصعوبة تطبيق أحكام
الشريعة اليهودية بحقه من قبل اليهود، وتلك من اجتهادات الحاخامات وأساليب تحايلهم
على تطبيق الشريعة. وما يبرهن على ذلك اتخاذ قرار الانسحاب الإسرائيلي من جانب
واحد، مما يعني عدم إعطاء أي اعتبار للجانب الفلسطيني في هذا الحل، وقد نشرت صحيفة
“هاآرتس” 28/7/،2005 مقالة مثيرة للانتباه، كتبها المفكر والمؤرخ الصهيوني البارز "يرون
بنفنستي" قال فيها: إن شارون وأعوانه حين أطلقوا مبادرة الانسحاب من غزة، دون
أي اتفاق أو تفاهم مع السلطة الفلسطينية، فإنهم من الناحية العملية أجهزوا على آخر
بقايا مرحلة أوسلو، التي قامت على الاعتراف بالفلسطينيين كطرف شرعي، يمثل مجموعة
سكانية تستحق أن تمتلك حق تقرير مصيرها. وقد وصف الخطوة أحادية الجانب بأنها
بمثابة إعادة العجلة إلى الوراء، للفترة التي حاولت فيها “إسرائيل” استلاب حق
الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم. مدعية أهم ليسوا كيانًا ثقافيًا وسياسيًا وشرعيًا،
وإنما هم مجموعة من “الإرهابيين”، الذين يتعين عدم إشراكهم في أية مفاوضات. وأبدى
الرجل دهشته من أن بعض الأطراف العربية التي تختلف جذريًا في هذه النظرة
للفلسطينيين، تبدي حماسًا لمساعدة شارون على تنفيذ خطته، التي يرفض فيها أية
محاولة لإجراء مفاوضات طبيعية بين طرفي الصراع([23]).
وكما قال "فهمي هويدي" عن خطة
"شارون" في الانسحاب من غزة: «الانسحاب من غزة إنجاز مسموم، لا تستطيع
أن ترفضه، ولا تستطيع أن تقبل بنتائجه. وبالمعيار النسبي هو خطوة إلى الأمام، لكن
أخشى ما أخشاه أن تستصحب معها عشر خطوات إلى الوراء، بحيث تتخلص “إسرائيل” من
كابوس غزة، لكي تبتلع الضفة وتجهض الحلم الفلسطيني»([24]).
فالانسحاب من غزة في الأصل خطة تنطوي على نوايا خبيثة لمواجهة "الأجنبي"
الفلسطيني الذي يعيش فيها ويسبب مشكلة خطيرة في وجه الأحلام الصهيونية التلمودية.
وإن كان هناك تعارض من حيث الشكل بين ما تنص عليه الشريعة اليهودية فيما يتعلق
بكيفية التعامل مع الأجنبي الذي يعيش على "أرض إسرائيل" والتي لا يجوز
التخلي عن ملكيتها أو السيطرة عليها وإدراتها عند احتلالها وبين قرار الانسحاب
الأحادي الجانب، فإنه لا تعارض من حيث الأصل إذا علمنا جوهر الخطة الإسرائيلية
ومضمونها ومدى انسجامها مع الفكر الديني اليهودي والمشروع الصهيوني وآلية تنفيذه.
[8]))
مجلة فلسطين المسلمة، العدد (6) حزيران، 1994. إبراهيم غرايبة، (قتل
غير اليهودي...واجب ديني..)، ص51.